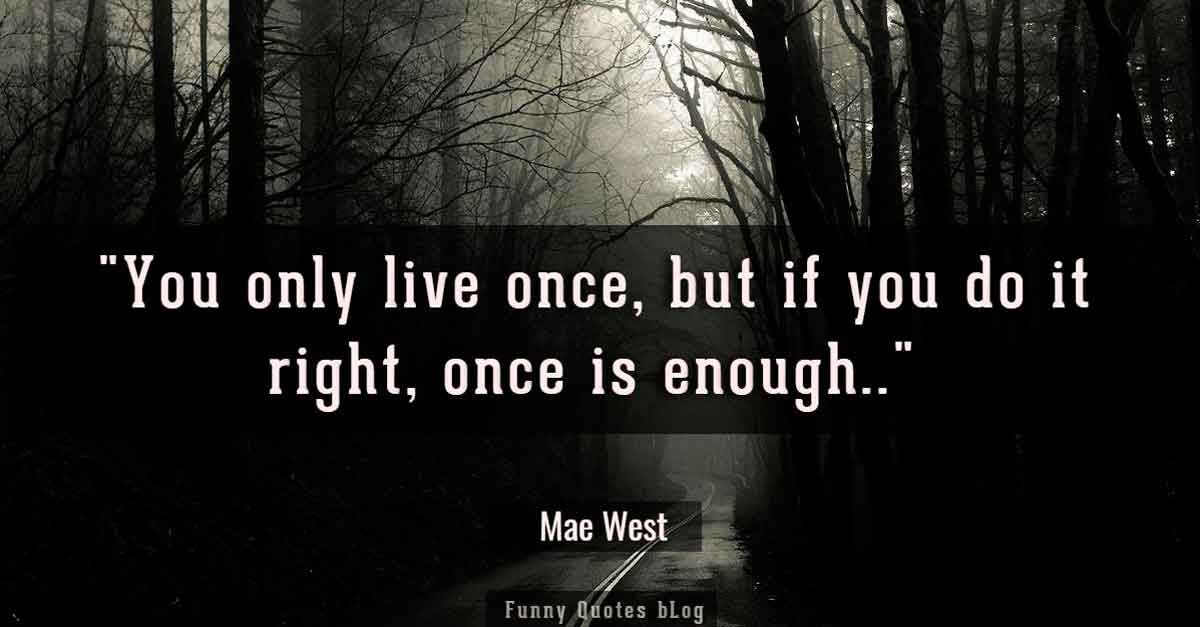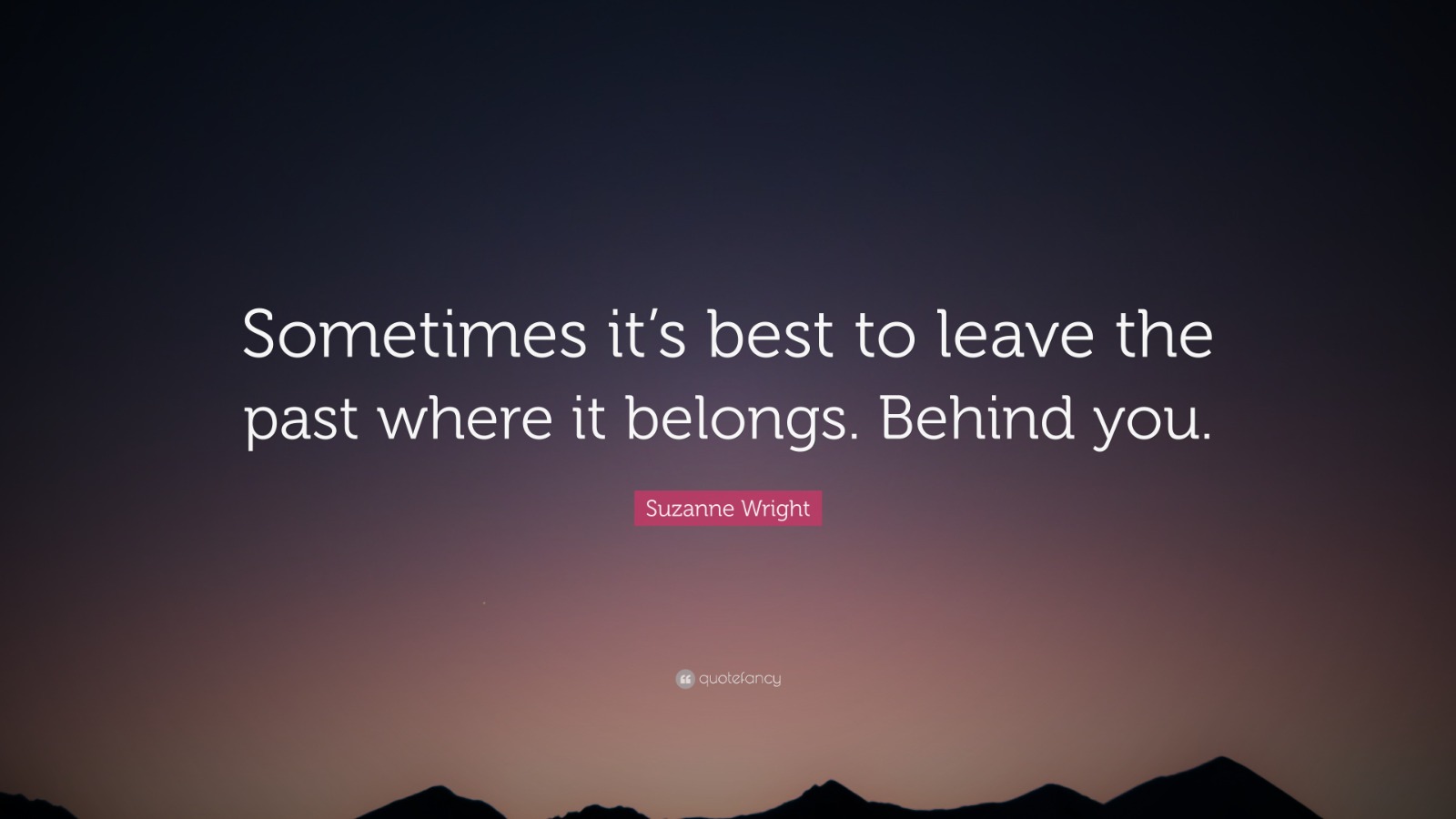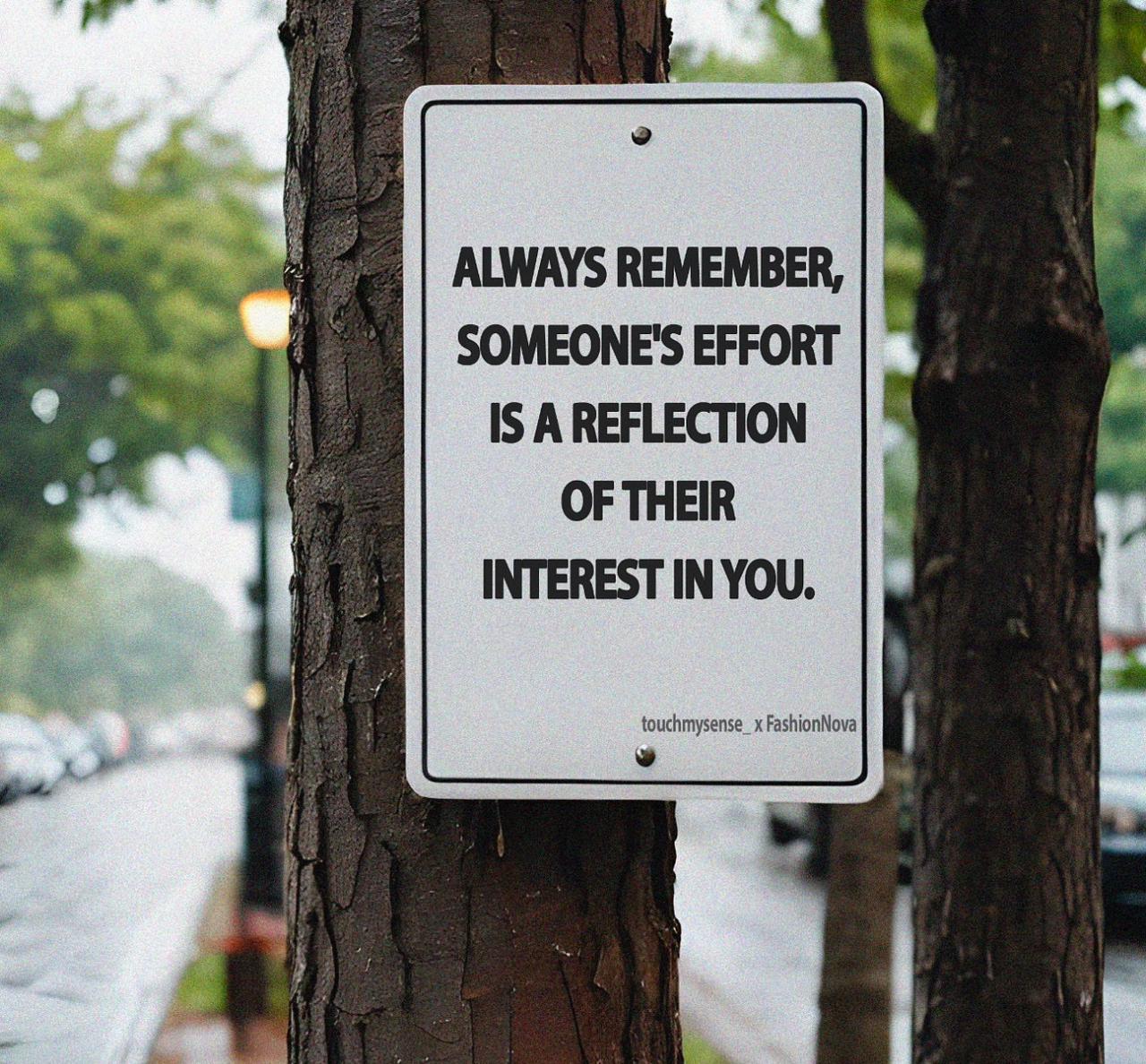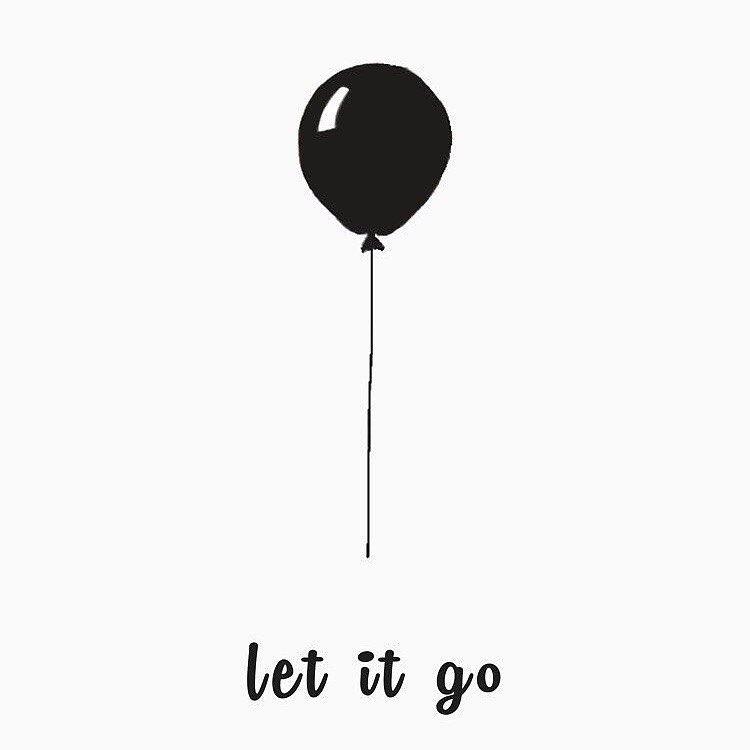<p>بÙÙÙ / شرÙÙ ÙادÙ.. اÙØ£Ù Ù٠اÙعا٠ÙÙÙ Ùظ٠ة اÙ٠صرÙØ© ÙØÙÙ٠اÙØ¥ÙساÙ</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-11982" src="https://alshamsnews.com/wp-content/uploads/2025/04/02-246x300.jpg" alt="" width="246" height="300" /></p>
<p>تÙعد اÙبرازÙÙ ÙاØدة ٠٠اÙدÙ٠اÙرائدة Ù٠أ٠رÙÙا اÙÙاتÙÙÙØ© Ù٠تبÙÙ٠سÙاسات Ø¥ÙساÙÙØ© تجا٠اÙÙ ÙاجرÙÙ ÙاÙÙاجئÙÙØ Ø¥Ø° تعت٠د عÙ٠تشرÙعات تÙد٠ÙØ© تعÙس اØترا٠Ùا ÙØÙÙ٠اÙØ¥Ùسا٠ÙاÙتزا٠Ùا باÙتضا٠٠اÙدÙÙÙ. ÙØ®Ùا٠اÙسÙÙات اÙأخÙØ±Ø©Ø Ø´Ùدت اÙبÙاد تطÙرÙا Ù ÙØÙظÙا Ù٠اÙتعا٠٠٠ع ÙضاÙا اÙÙجرة ÙاÙÙجÙØ¡ ÙاÙتجÙÙØ³Ø Ù Ù Ø§ جعÙÙا ÙÙ ÙذجÙا ÙÙØتذ٠ب٠Ù٠اÙÙ ÙØ·ÙØ©.</p>
<h2>ÙاÙÙ٠اÙÙجرة اÙجدÙد Ù٠اÙبرازÙÙ</h2>
<p>Ù٠خطÙØ© غÙر ٠سبÙÙØ©Ø Ø£ÙرÙت اÙبرازÙ٠اÙÙاÙÙ٠رÙÙ 13.445 Ùعا٠2017Ø Ø§Ù٠عرÙ٠بÙ&#8221;ÙاÙÙ٠اÙÙجرة اÙجدÙد&#8221;Ø ÙاÙذ٠دخ٠ØÙز اÙتÙÙÙØ° ÙÙ ÙÙÙ٠بر ٠٠اÙعا٠ذاتÙØ ÙÙØÙ Ù ØÙ &#8220;ÙاÙÙ٠اÙأجاÙب&#8221; اÙØ°Ù ÙعÙد Ø¥ÙÙ ØÙبة اÙØÙ٠اÙعسÙرÙ. ÙÙÙ Ø«Ù Ùذا اÙÙاÙÙ٠تØÙÙÙا جÙÙرÙÙا ÙÙ ÙÙج اÙدÙÙØ© تجا٠اÙÙ ÙاجرÙÙØ Ø¥Ø° ÙÙÙ٠عÙ٠٠بادئ ØÙÙ٠اÙØ¥Ùسا٠ÙاÙ٠ساÙاة ÙÙ Øاربة اÙت٠ÙÙز.</p>
<h2>Ù٠٠أبرز بÙÙد اÙÙاÙÙÙ:</h2>
<p>اÙاعترا٠باÙÙ ÙاجرÙÙ ÙØ£Ùراد Ùت٠تعÙ٠باÙÙرا٠ة اÙØ¥ÙساÙÙØ© ÙاÙØÙÙ٠اÙأساسÙØ©.</p>
<p>تسÙÙ٠إجراءات اÙØصÙ٠عÙ٠اÙتأشÙرات ÙاÙØ¥Ùا٠ة اÙدائ٠ة.</p>
<p>تÙدÙÙ Ø٠اÙØ© خاصة ÙضØاÙا اÙاتجار باÙبشر ÙاÙاستغÙاÙ.</p>
<p>تعزÙز اÙإد٠اج اÙاجت٠اع٠ÙاÙاÙتصاد٠ÙÙÙ ÙاجرÙÙ ÙاÙÙاجئÙÙ.</p>
<h2>سÙاسات اÙÙجÙØ¡ ÙØ٠اÙØ© اÙÙاجئÙÙ Ù٠اÙبرازÙÙ</h2>
<p>تتبÙ٠اÙبرازÙ٠سÙاسة ÙجÙØ¡ ٠تÙد٠ة ٠ستÙدة Ø¥Ù٠اتÙاÙÙØ© جÙÙÙ Ùعا٠1951 ÙبرÙتÙÙÙÙÙا Ùعا٠1967Ø Ø¥Ù٠جاÙب &#8220;إعÙا٠ÙرطاجÙØ©&#8221; اÙØ¥ÙÙÙÙ Ù. Ùت٠ÙØ Ø§ÙØ٠اÙØ© ÙÙاجئÙ٠اÙÙارÙ٠٠٠اÙاضطÙØ§Ø¯Ø Ø§ÙÙزاعات اÙ٠سÙØØ©Ø Ø£Ù Ø§Ùأز٠ات اÙØ¥ÙساÙÙØ©.</p>
<p>Ù٠٠بÙ٠أبرز اÙ٠بادرات ÙÙ Ùذا اÙسÙا٠&#8220;ع٠ÙÙØ© اÙترØÙب&#8221; (Operação Acolhida)Ø Ø§Ùت٠أطÙÙتÙا اÙØÙÙÙ Ø© Ù ÙØ° عا٠2018 ÙاستÙبا٠آÙا٠اÙÙÙزÙÙÙÙÙ٠اÙÙاربÙ٠٠٠اÙأز٠ة اÙاÙتصادÙØ© ÙاÙسÙاسÙØ© Ù٠بÙادÙÙ . Ùتش٠٠اÙع٠ÙÙØ© تÙÙÙر اÙ٠أÙÙØ ÙاÙرعاÙØ© اÙصØÙØ©Ø ÙاÙØºØ°Ø§Ø¡Ø Ø¨Ø§ÙإضاÙØ© Ø¥Ù٠دع٠إعادة اÙتÙØ·ÙÙ Ù٠٠د٠أخر٠داخ٠اÙبرازÙÙØ ÙØ°Ù٠باÙشراÙØ© ٠ع اÙأ٠٠اÙ٠تØدة ÙÙ Ùظ٠ات اÙ٠جت٠ع اÙ٠دÙÙ.</p>
<h2>اÙتجÙÙس Ù٠اÙبرازÙÙ: ÙÙاÙÙ٠٠رÙØ© Ùجاذبة</h2>
<p>تعت٠د اÙبرازÙÙ Ùظا٠&#8220;Ø٠اÙأرض&#8221; (Jus Soli)Ø ØÙØ« ÙØص٠أ٠طÙÙ ÙÙÙد عÙ٠اÙأراض٠اÙبرازÙÙÙØ© عÙ٠اÙجÙسÙØ© تÙÙائÙÙØ§Ø Ø¨ØºØ¶ اÙÙظر ع٠جÙسÙØ© ÙاÙدÙÙ. Ù٠ا تÙÙر اÙدÙÙØ© Ø¢ÙÙات تجÙÙس Ù ÙسÙرة ÙÙÙ ÙاجرÙÙØ ÙÙ٠اÙشرÙØ· اÙتاÙÙØ©:</p>
<p>اÙØ¥Ùا٠ة اÙÙاÙÙÙÙØ© Ù٠دة أربع سÙÙات عÙ٠اÙØ£ÙÙ.</p>
<p>إتÙا٠اÙÙغة اÙبرتغاÙÙØ©.</p>
<p>سج٠جÙائ٠ÙظÙ٠داخ٠اÙبرازÙÙ ÙÙ٠بÙد اÙÙ Ùشأ.</p>
<p>ÙÙÙ Ù٠تÙÙÙص Ùترة اÙØ¥Ùا٠ة اÙÙ Ø·ÙÙبة Ù٠بعض اÙØاÙات:</p>
<p>سÙتا٠ÙÙØ· ÙÙ Ù Ùد٠Ùا خد٠ات جÙÙÙØ© ÙÙبرازÙ٠أ٠Ù٠تÙÙÙÙ Ù Ùارات استثÙائÙØ© أ٠عدÙ٠٠اÙجÙسÙØ©.</p>
<p>سÙØ© ÙاØدة ÙÙØ· ÙÙ٠تزÙجÙ٠٠٠برازÙÙÙÙ٠أ٠اÙØ°ÙÙ ÙدÙÙ٠أبÙاء برازÙÙÙÙ٠أ٠اÙÙاد٠Ù٠٠٠دÙÙ ÙاطÙØ© باÙبرتغاÙÙØ©.</p>
<p>Ù٠ا ØªØ³Ù Ø Ø§ÙبرازÙ٠بازدÙاج اÙجÙسÙØ©Ø Ù Ø§ ÙتÙØ ÙÙ٠جÙسÙ٠اÙاØتÙاظ بجÙسÙتÙ٠اÙأصÙÙØ©Ø ÙÙ٠عا٠٠جذب رئÙس٠ÙÙراغبÙÙ Ù٠اÙØÙاظ عÙ٠رÙابطÙ٠اÙØ«ÙاÙÙØ© ÙاÙÙØ·ÙÙØ©.</p>
<h2>اÙتØدÙات ÙاÙØ¢Ùا٠اÙ٠ستÙبÙÙØ©</h2>
<p>رغ٠اÙإطار اÙÙاÙÙÙ٠اÙ٠تÙØ¯Ù Ø Ùا تزا٠ÙÙا٠تØدÙات تÙاج٠تÙÙÙØ° Ùذ٠اÙسÙØ§Ø³Ø§ØªØ Ø£Ø¨Ø±Ø²Ùا بطء اÙإجراءات اÙبÙرÙÙراطÙØ© ÙÙÙص اÙÙ ÙØ§Ø±Ø¯Ø Ùا سÙ٠ا Ù٠اÙÙ Ùاط٠اÙØدÙدÙØ© Ù Ø«Ù ÙÙاÙØ© رÙراÙÙ Ø§Ø Ø§Ùت٠تستÙب٠آÙا٠اÙÙÙزÙÙÙÙÙÙ Ø´ÙرÙÙا.</p>
<p>غÙر أ٠اÙتعاÙ٠اÙÙØ«Ù٠بÙ٠اÙØÙÙÙ Ø© اÙبرازÙÙÙØ© ÙاÙÙ Ùظ٠ات اÙدÙÙÙØ© ÙاÙ٠جت٠ع اÙ٠دÙ٠ساÙÙ Ù٠تØسÙ٠اÙØ£Ùضاع تدرÙجÙÙØ§Ø Ùسط تÙÙعات ب٠ÙاصÙØ© تطÙÙر اÙسÙاسات Ùض٠ا٠إد٠اج اÙÙ ÙاجرÙ٠بشÙ٠أÙثر ÙعاÙÙØ©.</p>
<h2>ÙÙ Ùذج ÙÙØتذ٠بÙ</h2>
<p>ت٠ث٠تجربة اÙبرازÙÙ Ù٠اÙتعا٠٠٠ع ÙضاÙا اÙÙجرة ÙاÙÙجÙØ¡ ÙاÙتجÙÙس ÙÙ ÙذجÙا ÙÙØتذ٠ب٠Ù٠اØترا٠ØÙÙ٠اÙØ¥Ùسا٠ÙتعزÙز اÙتعاÙ٠اÙدÙÙÙ. ÙÙعÙس Ùذا اÙÙÙج اÙتزا٠اÙبرازÙ٠بÙÙ٠اÙØ¥ÙساÙÙØ© ÙاÙعداÙØ© اÙاجت٠اعÙØ©Ø Ù Ø§ ÙجعÙÙا ÙجÙØ© Ù ÙضÙØ© ÙÙعدÙد ٠٠اÙباØØ«Ù٠ع٠اÙأ٠ا٠ÙاÙÙرا٠ة.</p>
<p><strong>اÙرا Ø£Ùضا</strong></p>
<p><a href="https://alshamsnews.com/2025/04/02/%d9%87%d9%84-%d8%aa%d8%aa%d8%ae%d9%84%d9%8a-%d8%b9%d9%86%d9%87%d9%85-%d8%a5%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d9%84-%d8%aa%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%b9-%d8%b9%d9%86-%d8%ae%d8%b7%d8%a9-%d8%aa%d8%b4%d8%ba/">Ù٠تتخÙ٠عÙÙÙ ..إسرائÙ٠تتراجع ع٠خطة تشغÙ٠درÙز سÙرÙا Ù٠أراضÙÙا</a></p>

التصنيف: أراء ومقالات
سوريا على أطلال هوبز
<p>بÙÙÙ / Ù Ø٠د ج٠عة Ø£Ùا</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-11877" src="https://alshamsnews.com/wp-content/uploads/2025/01/000-219x300.jpeg" alt="" width="219" height="300" /></p>
<p>ÙÙØªØ±Ø ÙÙبز ÙÙ Ùتاب٠&#8220;اÙÙÙÙÙاثاÙ&#8221; ٠ا ÙÙ Ù٠تس٠Ùت٠بÙرضÙØ© &#8220;ابتزاز اÙØ٠اÙØ©&#8221;Ø ÙÙÙ Ùائ٠ة عÙ٠اÙتخÙ٠اÙإراد٠ÙÙØ٠اÙذات٠Ù٠اÙØرÙØ© Ù٠سبÙ٠اÙØÙاظ عÙ٠أ٠٠اÙج٠اعة &#8220;غرÙزة اÙÙ ØاÙظة عÙ٠اÙذات&#8221;. Ù٠ا د٠ت باعتبار٠أÙا اÙدÙÙØ© اÙت٠ÙÙØدÙا تستطÙع أ٠تØÙ ÙÙ٠٠٠أÙÙسÙÙ &#8220;Øرب اÙÙ٠ضد اÙÙÙ&#8221;Ø ÙØ¥ÙÙ Ù Ù ÙاجبÙ٠أ٠تتخÙÙا ع٠ØرÙتÙÙ . ÙÙÙا Ù٠ارس اÙÙÙÙÙاثا٠اÙØ´Ù٠اÙØ£Ùص٠Ùع٠ÙÙØ© اÙØ§Ø¨ØªØ²Ø§Ø²Ø ÙÙÙ٠ا ازداد اÙØ®ÙÙ ÙÙ٠ا ÙÙض اÙÙÙÙÙاثا٠ÙتÙÙÙÙØ ÙØ°Ù٠تØت بÙد اÙØ٠اÙØ©.</p>
<h2>اÙدÙÙØ© ÙÙ ÙÙر ÙÙبز</h2>
<p>Ø¥Ù ÙÙبز ÙÙد٠ÙÙا Ùبجدارة ÙØ«ÙÙØ© ÙØ´ÙØ¡ اÙدÙÙØ© Ù٠ذاتÙØ§Ø Ø£Ù ØªÙ٠اÙدÙÙØ© اÙت٠ت٠تÙ٠اÙجÙاز اÙعÙÙ٠اÙ٠جرد ÙاÙت٠تستطÙع ٠٠ارست٠٠ت٠تشاء ٠ادا٠ت ت٠تÙ٠اÙØجة اÙأخÙاÙÙØ© &#8220;Ø٠اÙØ© اÙج٠اعة&#8221;.</p>
<h2> خطر اÙتÙارب اÙÙÙÙات٠عÙد ÙÙبز</h2>
<p>ÙÙ Ùختر اÙÙÙÙسÙ٠اÙØ¥ÙجÙÙز٠&#8220;ÙÙبز&#8221; Ùذا اÙ٠ثا٠٠٠اÙدÙÙØ© ترÙÙØ§Ø ÙÙ٠أدر٠أ٠اÙÙÙ Ø· اÙ٠عاش ٠٠اÙتشÙÙÙات اÙاجت٠اعÙØ© &#8220;اÙÙÙÙاتÙØ©&#8221; جدÙر٠بأ٠ÙÙتÙ٠إÙ٠اÙÙراض اÙØ¥ÙساÙØ Ø£Ù ØªÙ٠اÙ٠جت٠عات اÙت٠تتبÙ٠اÙØ´Ù٠اÙÙØ´ ٠٠اÙÙÙÙØ© باعتبار٠اÙØÙ٠اÙÙ ÙÙÙ٠٠اÙÙØÙد ÙÙاÙت٠اء.</p>
<p>إ٠اÙتÙارب اÙÙÙÙÙØ Ø³Ùاء بشÙÙ٠اÙطائÙ٠أ٠اÙعرÙ٠أ٠اÙدÙÙ٠أ٠اÙجÙÙÙØ Ù٠ب٠ثابة اÙإعÙا٠اÙصرÙØ Ø¹Ù Ø²Ùا٠اÙ٠جت٠عات. ÙÙع٠أÙبر Ø£Ù Ø«ÙتÙا ع٠Ùذ٠اÙتطبÙÙØ© اÙÙÙبزÙØ©Ø Ù٠٠ا تعÙش٠اÙج٠اعات اÙ٠تÙاس٠ة اÙÙ ÙسÙÙ Ø© داخ٠اÙدÙÙØ© اÙسÙرÙØ© &#8220;Øرب اÙÙ٠ضد اÙÙÙ&#8221;.</p>
<h2> أز٠ة اÙÙÙÙØ© Ù٠سÙرÙا</h2>
<p>اÙÙÙÙات اÙ٠تعددة ÙاÙ٠تشعبة اÙت٠تطÙ٠عÙ٠اÙÙج٠اÙسÙر٠ÙÙÙÙØ© بأ٠تجع٠Ùذ٠اÙبÙعة اÙجغراÙÙØ© ساØØ© ٠عرÙØ© تÙرارÙØ© ÙÙا ÙÙائÙØ©. Ù٠ا د٠ت Ùا أتÙÙر Ø¥Ùا عÙ٠صÙغ ٠عÙÙØ© ٠٠اÙاÙØªÙ Ø§Ø¡Ø ÙÙ٠اÙصÙغة اÙأسÙØ£Ø ÙÙÙا ÙÙصد اÙاÙت٠اء ÙÙÙÙÙØ©Ø Ùإ٠اÙآخر اÙ٠ختÙ٠عÙ٠سÙتØÙÙ Ù٠ذات اÙÙØظة Ø¥Ù٠عدÙ.</p>
<p>Ùباعتبار٠أ٠ÙÙ ÙÙÙØ©Ù ÙرÙدة٠تستÙ٠٠٠اÙØ£Ùا ج٠اعÙØ© عÙجÙÙتÙØ§Ø Ùإ٠اÙآخر ÙØµØ¨Ø Ù Ø¹Ø¯Ù٠اÙØ®Ùار أ٠ا٠Ùذا اÙغÙ٠اÙÙÙÙاتÙØ Ùإ٠ا Ø£Ù Ùضطر Ø¥Ù٠اÙإد٠اج ٠ع٠أ٠Ùتعرض Ø¥Ù٠اÙÙÙ٠اÙÙجÙدÙ.</p>
<h2> اÙÙت٠اÙعبث٠ÙاÙÙÙÙØ© اÙÙاتÙØ©</h2>
<p>Ø¥Ù Ùذا اÙÙائض اÙÙاعÙÙاÙ٠٠٠اÙÙ ÙاجÙØ© بÙ٠اÙÙÙÙØ§ØªØ Ø³Ùاء اÙطائÙÙØ© أ٠اÙعرÙÙØ© أ٠اÙدÙÙÙØ© أ٠اÙجÙÙÙØ©Ø ÙØÙÙ٠اÙØ¥Ùسا٠اÙسÙر٠إ٠ا Ø¥ÙÙ Ùات٠أ٠٠ÙتÙÙØ ÙÙ Ù Ø«Ù ÙÙ٠٠ضطر Ø¥Ù٠أ٠Ùست٠Ù٠عÙ٠استراتÙجÙØ© ٠عÙÙØ© ÙÙÙÙÙØ© اÙØÙاظ عÙÙ ÙÙسÙØ ÙØ°ÙÙ Ù Ù Ø®Ùا٠اÙاÙت٠اء Ø¥Ù٠اÙج٠اعة اÙÙÙÙÙØ© اÙÙادرة عÙ٠اÙÙ ÙاجÙØ©.</p>
<p>ÙÙÙ ÙاتÙÙ ÙÙÙ ÙÙ ÙÙ ÙÙÙÙÙت٠ÙاتÙ٠جباÙ. Ø¥ÙÙ Ùا ÙÙ ÙÙ Ù Ùدرة٠ØÙÙÙØ©Ù ÙÙØÙاظ عÙ٠ذات٠اÙ٠رÙÙØ© Ø¥Ùا بع٠ÙÙØ© Ùت٠اÙØ¢Ø®Ø±Ø ÙÙ٠دائ٠ا٠ÙعÙØ´ أز٠ة Ø®ÙÙ. Ù٠٠ث٠تخÙض اÙج٠اعة ع٠ÙÙØ© Ùت٠عبثÙØ©Ø Ø¥Ø° إ٠اÙÙتا٠اÙÙÙÙ٠٠جرد٠٠٠أ٠Ùد٠أخÙاÙÙ.</p>
<h2>اÙÙتا٠اÙطائÙÙ</h2>
<p>اÙاÙتتا٠اÙطائÙÙ Ù Ø«Ùا٠Ùا ÙظÙر ÙÙØ· ÙØ£Ù٠٠دÙÙع بÙراÙÙة٠تجا٠اÙØ¢Ø®Ø±Ø Ø¨Ù Ø¹Ù٠أÙ٠غÙر ٠جبÙÙÙ ÙÙØ· باÙØاÙØ© اÙساÙÙÙÙÙجÙØ©. إ٠أساس اÙاÙتتا٠اÙطائÙ٠إÙ٠ا ÙØ٠٠عÙ٠بÙعد٠اÙØÙÙاÙÙØ ÙÙ٠غرÙزة اÙÙ ØاÙظة عÙ٠اÙذات.</p>
<p>ÙبÙرÙØ©Ù ÙاØØ¯Ø©Ø Ùإ٠اÙاستع٠ا٠اÙÙÙÙاتÙØ Ø³Ùاء بشÙÙ٠اÙطائÙ٠أ٠اÙعرÙ٠أ٠اÙجÙÙÙ ÙØ®Ù٠ع٠ÙÙØ© اÙاÙØªÙ Ø§Ø¡Ø Ø¥Ù٠ا ÙÙ Ù٠٠ض٠ÙÙ٠أسÙØ£ Ø£ÙÙاع اÙاÙت٠اء. Ø¥Ù٠اÙØ´Ù٠اÙبدائ٠ÙاÙØÙÙاÙÙ ÙÙØ¨Ø´Ø±Ø Ø§Ùت٠ÙطاÙ٠ا ÙÙضت اÙØ«ÙاÙات ÙاختÙطت Ùتدا٠جت Ùت٠ازجت ÙإزاØØ© Ùذا اÙØ´Ù٠اÙعÙÙÙ ÙÙ Ù Ùاب٠اÙØªØ±Ø§Ø Ø£Ø´ÙاÙÙ ØÙÙÙة٠أخر٠٠٠أÙثرÙبÙÙÙجÙتÙا.</p>
<h2>اÙÙ Ùت بÙا ٠عÙÙ</h2>
<p>إ٠اÙسÙ٠داخ٠اÙبÙعة اÙسÙرÙØ© عÙد٠ا ÙÙت٠عÙÙÙا٠أ٠باÙعÙØ³Ø ÙØ¥ÙÙ ÙÙد٠Ùذا اÙع٠٠اÙعÙÙÙ ÙاÙبدائ٠ÙÙاÙت٠اء. Ø¥ÙÙ Ù٠تÙ٠اÙÙØظة ÙستÙÙ٠٠٠أÙثرÙبÙÙÙجÙت٠ÙÙÙد٠أسخ٠ÙÙ Ø· ٠٠أÙ٠اط اÙاÙت٠اء.</p>
<p>ÙÙÙا ÙتØÙ٠اÙÙت٠إÙÙ Ù Ùت بÙا ٠عÙ٠أ٠بÙا ÙدÙØ ÙÙ Ù Ø«Ù ÙØµØ¨Ø Ø§ÙÙت٠عددÙا٠Ùا ÙØ٠٠بÙ٠جÙبات٠أÙØ© رؤÙØ©. إ٠اÙاÙتتا٠اÙطائÙÙ ÙÙس ٠٠ارسة٠ÙÙعÙÙØ ÙØت٠اÙعÙÙ ÙØÙ Ù Ù٠داخÙ٠بعض اÙج٠اÙÙات.</p>
<h2> غÙاب اÙÙÙÙÙاثا٠اÙسÙرÙ</h2>
<p>أ٠ا٠Ùذا اÙÙائض ٠٠اÙÙتÙØ ÙÙØªØ±Ø ÙÙبز ØÙا٠٠٠اÙØ®Ø§Ø±Ø¬Ø Ø£Ù ÙÙتج ÙÙبز ٠صدرا٠خارجÙا٠Ù٠ب٠ثابة &#8220;اÙØ£Ùا اÙÙاÙرة&#8221;Ø Ø£Ù Ù٠ا Ùس٠Ù٠اÙÙÙÙسÙ٠اÙÙرÙس٠جا٠ÙاÙا٠&#8220;اÙآخر اÙÙبÙر&#8221;Ø Ø§ÙØ°Ù ÙستطÙع Ø£Ù Ùضبط Ùذ٠اÙØ·Ùائ٠ب٠ا ت٠تÙÙÙ Ù Ù ÙÙØ© عÙÙÙØ© ÙشرعÙØ© Ùادرة عÙ٠ضبط اÙÙÙÙات.</p>
<p>٠ا ÙشاÙد٠داخ٠سÙرÙا اÙجدÙدة ٠٠اØتÙار Ø٠٠اÙسÙØ§Ø Ùضبط اÙج٠اعات اÙ٠سÙØØ© ÙتÙØÙد اÙجÙØ´ ÙÙ ÙÙÙا تÙÙÙعات عÙÙ Ù ÙØªØ±Ø ÙÙØ¨Ø²Ø ÙاÙذ٠س٠ÙÙا٠&#8220;ابتزاز اÙج٠اعة&#8221;. ÙÙÙ٠٠ا ÙÙتÙد٠Ù٠اÙØاÙØ© اÙسÙرÙØ© Ù٠اÙعا٠٠اÙساÙÙÙÙÙجÙØ ÙÙ٠٠ا ÙÙبÙÙا Ø¥ÙÙÙ ÙÙبز: Ø£Ù Ù ÙÙÙ٠بÙاء اÙدÙÙØ© Ùبدأ ÙØاÙØ© ساÙÙÙÙÙجÙØ©.</p>
<h2>ÙØ٠تعدÙ٠اÙشعÙر اÙاجت٠اعÙ</h2>
<p>٠ا ÙتطÙب٠اÙÙضع اÙسÙر٠ÙÙس Ø¥Ùتاج برا٠ج سÙاسÙØ© أ٠إدارÙØ©Ø Ø¨Ù Ø¥Ø¹Ø§Ø¯Ø© بÙاء اÙÙÙÙÙÙØ© اÙاجت٠اعÙØ©Ø Ø¨Ù Ø¹Ù٠آخر تعدÙ٠اÙشعÙر اÙاجت٠اع٠ÙØ¥Ùتاج اÙØ«ÙØ© بÙ٠اÙ٠جت٠عات Ù Ù Ø®ÙØ§Ù Ø·Ø±Ø Ø³ÙسÙÙÙÙجÙا ٠غاÙرة.</p>
<p>اÙسؤا٠اÙØ¢Ù: ÙÙ ÙÙ ÙÙ ÙسÙرÙا أ٠تÙتج &#8220;ÙÙÙÙاثاÙ&#8221; خاصا٠بÙØ§Ø Ø§ÙÙ Ø´ÙÙØ© Ùا تÙÙ Ù ÙÙ Ø·Ø±Ø Ø§ÙÙÙÙÙاثاÙØ Ø¨Ù Ù٠أ٠أ٠٠غا٠رة Ù٠إÙتاج ÙÙÙÙاثا٠جدÙد Ùد Ùا تخرج ع٠٠غا٠رة إعادة Ø¥Ùتاج اÙÙظا٠اÙسابÙ.</p>
<p><strong>اÙرا Ø£Ùضا</strong></p>
<p><a href="https://alshamsnews.com/2025/01/24/%d9%84%d9%82%d8%a7%d8%a1-%d9%85%d8%b1%d8%aa%d9%82%d8%a8-%d9%8a%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d9%82%d8%a7%d8%a6%d8%af-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%85%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b7%d9%8a/">ÙÙاء ٠رتÙب Ùج٠ع Ùائد سÙرÙا اÙدÙÙ ÙراطÙØ© ÙØ£Ø٠د اÙشرع..Ùذا ٠ا سÙÙاÙØ´ÙÙ</a></p>

سوريا.. الجرح المتقيّح المفتوح على كلّ الالتهابات
<p>سÙÙ٠ا٠٠ØÙ Ùد</p>
<p>Øدث٠جدÙÙ ÙبÙر٠ØÙÙ٠تعدÙ٠بعض اÙعبارات ÙاÙÙ ÙاÙÙÙ Ù٠اÙÙ ÙاÙج اÙدراسÙØ© Ù٠سÙرÙا- بعد اÙتصار (اÙØ«Ùرة) ÙسÙÙØ· اÙÙظا٠اÙسابÙ. Ù٠٠أÙثر اÙØ£Ù Ùر إثارة٠ÙÙجد٠عبارة٠ت٠٠تعدÙÙÙØ§Ø ØªÙدÙد٠اÙسÙ٠٠اÙØ£ÙÙÙÙ ÙاÙاÙت٠اء٠اÙÙØ·ÙÙÙ.</p>
<p>ÙØ£Ù Ùا اÙÙدÙÙ Ø©Ù ÙاÙت٠ÙاÙت ٠عت٠دة٠ÙÙ Ùتاب اÙدÙاÙØ© اÙإسÙا٠ÙØ©Ø ØªÙÙÙ٠إÙ٠٠عÙÙ (اÙ٠غضÙب عÙÙÙÙ Ø ÙاÙضÙاÙÙÙ) ÙÙ(اÙÙ ÙبتعدÙ٠ع٠سÙب٠اÙØ®Ùر)Ø Ùت٠٠تعدÙÙÙا Ø¥ÙÙ (اÙÙÙÙد ÙاÙÙصارÙ)!</p>
<p>ÙبÙ٠أ٠ÙتØدÙث٠ع٠بÙاء Ùظا٠٠سÙاسÙÙ Ù٠سÙرÙØ§Ø Ùجب٠أ٠Ùع٠Ù٠عÙ٠بÙاء Ùظا٠٠تشارÙÙÙ- ÙØ·ÙÙ- Ø«ÙاÙÙ- ÙسÙÙÙÙÙØ Ùظا٠٠٠ÙاطÙÙÙ- Ø¥ÙساÙÙÙØ ÙجعÙ٠سÙرÙا تÙÙ٠عÙÙ Ùد٠Ù٠صÙبتÙÙØ ÙاÙÙÙا٠٠ÙÙطبÙ٠عÙ٠دÙ٠شرÙÙا اÙبائس٠ÙÙÙا.</p>
<p>ÙÙ ÙضاÙا اÙاعتÙØ§Ø¯Ø Ø§ÙÙرآÙÙ Ùا ÙتÙاÙÙ ÙÙ٠بÙÙد Ø´ÙعرÙØ ÙÙÙÙ٠اÙØساب٠عÙÙÙا ÙÙ٠٠اÙÙÙØ§Ù Ø©Ø Ø£Ù Ùا ÙÙ ÙضاÙا اÙتعاÙØ´Ø ÙØ¥ÙÙ Ùدع٠إÙ٠اÙسÙ٠اÙØ£ÙÙÙÙØ Øت٠٠ع اÙ٠ختÙ٠٠ع٠عÙائدÙاÙ.</p>
<p>٠ع اÙأسÙØ ÙØ«Ùر٠٠Ùا ÙظÙ٠أÙ٠اÙ٠غضÙب٠عÙÙÙÙ ÙاÙضاÙÙÙ Ù٠اÙÙÙÙد٠ÙاÙÙصارÙØ ÙÙذا رأÙ٠بشرÙ٠٠خاÙÙÙ ÙÙÙرآÙØ ÙتÙسÙرÙÙ ÙارÙÙ ÙÙØ¢Ø®Ø±Ø Ø±Ø§Ùض٠ÙÙعÙØ´ ٠عÙØ Ùساعد٠عÙÙ Ø«ÙاÙØ© اÙÙØ·Ùعة ÙÙÙدÙد اÙسÙ٠٠اÙØ£ÙÙÙÙ.</p>
<p>Ùذا ÙÙ٠٠سÙÙÙÙØ ÙعÙد اÙعÙÙا٠Ùعت٠د٠عÙÙ ØدÙث٠آØØ§Ø¯Ø Ø¹Ù Ø¹Ø¯Ù٠ب٠ØØ§ØªÙ Ø Ø±Ùا٠اÙتر٠ذÙÙ ÙاÙإ٠ا٠أØÙ Ø¯Ø ÙÙا٠عÙ٠عÙ٠اء٠اÙØدÙØ« اÙسابÙÙ٠أÙ٠ضعÙ٠سÙدا٠Ù٠تÙاÙ: &#8221; ÙعÙ٠اÙÙÙ٠اÙÙÙÙد٠ÙاÙÙصارÙØ Ø§ØªÙخذÙا Ù Ù ÙبÙر Ø£ÙÙÙائÙ٠٠ساجدÙ..&#8221;Ø Ø¥Ø° ÙÙÙ ÙÙعÙÙ٠اÙرسÙÙÙ ÙاÙ٠سÙÙ ÙÙ Ùد اتÙخذÙا Ù Ù Ùبر ÙبÙÙÙ٠٠سجداÙ! Ù٠ا اتÙخذÙا Ù Ù ÙبÙر اÙصØابة Ùآ٠اÙبÙت ÙاÙأئ٠ة ٠ساجدÙ!</p>
<p>ÙÙÙ ÙÙعÙÙÙ ÙÙد Ø·Ùب٠٠٠أصØاب٠اÙÙجÙء٠إÙÙ Ùصار٠اÙØبشة! ÙÙÙ ÙÙعÙÙÙ ÙÙد تزÙÙج Ù ÙÙ٠٠ارÙÙØ© اÙÙبطÙØ©! ÙÙÙ ÙÙعÙÙÙ ÙÙد س٠ØÙ ÙÙØ£Øباش Ø£Ù ÙØتÙÙÙا بÙدÙاسÙÙ Ù٠٠سجدÙ! ÙÙÙ ÙÙعÙÙÙ ÙÙد ÙÙÙع ٠ع اÙÙÙÙد Ù ÙثاÙا٠ÙØ·ÙÙا٠٠٠خÙا٠صØÙÙØ© اÙ٠دÙÙØ©!&#8230;</p>
<blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="FCke2Eg14x"><p><a href="https://alshamsnews.com/2025/01/02/%d8%aa%d8%b3%d9%85%d9%85-%d8%a8%d8%b4%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%af-%d9%87%d9%84-%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d8%b6-%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85/">تس٠٠بشار اÙأسد..Ù٠تعرض رئÙس اÙÙظا٠اÙÙ Ø®ÙÙع ÙÙ ØاÙÙØ© اغتÙا٠ÙÙ Ù ÙسÙÙ Ø</a></p></blockquote>
<p><iframe class="wp-embedded-content" sandbox="allow-scripts" security="restricted" style="position: absolute; visibility: hidden;" title="&#8220;تس٠٠بشار اÙأسد..Ù٠تعرض رئÙس اÙÙظا٠اÙÙ Ø®ÙÙع ÙÙ ØاÙÙØ© اغتÙا٠ÙÙ Ù ÙسÙÙ Ø&#8221; &#8212; اÙش٠س ÙÙÙز" src="https://alshamsnews.com/2025/01/02/%d8%aa%d8%b3%d9%85%d9%85-%d8%a8%d8%b4%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%af-%d9%87%d9%84-%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d8%b6-%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85/embed/#?secret=EPazdRBH5a#?secret=FCke2Eg14x" data-secret="FCke2Eg14x" width="600" height="338" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe></p>
<p>ÙاÙØدÙث٠٠خاÙÙÙ Ùع٠٠اÙ٠سÙÙ ÙÙ ÙسÙÙØ© اÙÙبÙÙØ ÙÙذا ÙاÙÙ ÙإبطاÙÙØ Ù٠ا Ùا تÙجد٠ÙتÙÙ٠تراثÙØ© تÙÙÙ٠باÙدعاء عÙ٠اÙÙÙÙد ÙاÙÙصار٠Ù٠ا ÙÙع٠خطباء اÙÙÙÙ Ø ÙÙذا اÙدعاء٠ظÙر٠عÙ٠اÙÙ Ùابر Ù٠اÙ٠رة اÙØ£ÙÙ٠أثÙاء اÙØÙ Ùات اÙصÙÙبÙØ©Ø Ùت٠٠استث٠ارÙÙ ÙØ¥ØÙاؤ٠عÙد اØتÙا٠ÙÙسطÙÙØ ÙÙا ÙجÙز٠اÙدعاء٠باÙسÙØ¡ عÙ٠أÙ٠طائÙة٠أ٠ج٠اعة٠بعÙÙÙØ§Ø Øت٠ÙÙ ÙÙت٠تختÙ٠٠عÙ٠سÙاسÙا٠أ٠عÙائدÙاÙØ Ø¥Ø° Ùبدأ اÙÙعÙ٠اÙØÙÙÙÙÙ ÙتÙبÙ٠اÙبÙاد٠عÙد٠ا ÙÙÙ٠اÙتدÙÙÙ٠شأÙا٠ÙردÙا٠ÙاÙÙÙ٠اÙØ¥ÙساÙÙØ© شأÙا٠ÙØ«ÙاÙة٠ج٠عÙØ©Ø ÙÙ Ù ÙÙد٠إÙساÙÙت٠بطÙ٠تدÙÙÙÙ.</p>
<p>دعÙÙا ٠٠أصØاب اÙتÙسÙر ÙاÙØ£Ø«Ø±Ø ÙتعاÙÙا ÙÙر٠اÙÙرآÙÙ ÙÙÙÙ ÙÙظر٠ÙÙÙجÙÙ ÙÙØÙÙ Ù ÙÙÙسÙر ÙÙا Ù ÙÙ ÙÙ (اÙ٠غضÙب عÙÙÙÙ ÙاÙضاÙÙÙ)Ø ÙÙ٠٠ا ÙÙ Ù٠اÙاعت٠اد عÙÙ٠ب٠صطÙØ (تÙسÙر اÙÙرآ٠باÙÙرآÙ)Ø Ùذا اÙÙرآ٠اÙذ٠دعا دÙ٠ا٠إÙÙ Ø«ÙاÙØ© اÙتشارÙÙØ© Ùا Ø¥ÙÙ Ø«ÙاÙØ© اÙÙØ·ÙØ¹Ø©Ø ÙÙÙ٠تعاÙÙ: ( Ùا Ø£ÙÙا اÙÙاسÙØ Ø¥ÙÙا Ø®ÙÙÙاÙÙ Ù Ù Ø°Ùر٠ÙØ£ÙØ«ÙØ ÙجعÙÙاÙ٠شعÙبا٠ÙÙبائ٠ÙتعارÙÙØ§Ø Ø¥Ù٠أÙر٠Ù٠عÙد اÙÙ٠أتÙاÙÙ Ø Ø¥Ù٠اÙÙÙ٠عÙÙ٠٠خبÙر).( اÙØجرات 13)</p>
<p>ÙاÙضاÙÙÙ Ù٠اÙØ°ÙÙ ÙؤذÙ٠اÙÙاسÙØ ÙÙا Ùع٠ÙÙ٠اÙصاÙØاتÙØ ÙاÙدÙÙÙÙ ÙÙÙ٠تعاÙÙ Ù٠سÙرة اÙ٠ؤ٠ÙÙÙ: ( ÙاÙÙا ربÙا غÙبÙت٠عÙÙÙا Ø´ÙÙتÙÙØ§Ø ÙÙÙÙا ÙÙ٠ا٠ضاÙÙÙÙ)(اÙ٠ؤ٠ÙÙÙ 106). Ø£Ùضا٠Ù٠اÙÙاÙØ·Ù٠٠٠رØÙ Ø© اÙÙÙØ Ù٠ا Ù٠سÙرة اÙØجر: ( ÙÙ ÙÙ ÙÙÙØ· ٠٠رØÙ Ø© ربÙ٠إÙا٠اÙضاÙÙÙ)(اÙØجر 56). Ø£Ùضا٠اÙطغاة ÙاÙبÙØºØ§Ø©Ø Ù٠ا Ù٠سÙرة اÙÙ Ø·ÙÙÙÙ: ( Ùإذا رأÙÙÙ ÙاÙÙا Ø¥ÙÙ ÙؤÙاء ÙضاÙÙÙÙ)(اÙÙ Ø·ÙÙÙÙ 32).</p>
<p>Ø£Ù Ùا اÙ٠غضÙب عÙÙÙÙ Ø ÙÙ٠اÙÙاتÙÙØ: (ÙÙ Ù ÙÙتÙ٠٠ؤ٠ÙÙا٠٠تع٠Ùدا٠ÙجزاؤÙ٠جÙÙÙ٠٠خاÙدا٠ÙÙÙا Ùغضب٠اÙÙÙ٠عÙÙÙ Ùأعد٠Ù٠عذابا٠عظÙ٠اÙ)(اÙÙساء 93). ÙÙØ°Ù٠اÙظاÙ٠باÙÙ٠ظÙ٠اÙسÙØ¡Ø ÙÙÙ٠تعاÙÙ Ù٠سÙرة اÙÙتØ: (اÙظاÙÙ٠باÙÙ٠ظÙ٠اÙسÙØ¡ عÙÙÙ٠دائرة اÙسÙØ¡ Ùغضب اÙÙÙ٠عÙÙÙÙ ÙÙعÙÙÙ ..)(اÙÙØªØ 6). Ø£Ùضا٠٠٠اÙ٠غضÙب عÙÙÙÙ Ø´Ùداء٠اÙزÙØ±Ø ÙÙÙ٠تعاÙÙ: (Ø£Ù٠تر٠إÙ٠اÙØ°Ù٠تÙÙÙÙا ÙÙ٠ا٠غضب٠اÙÙÙ٠عÙÙÙÙ Ø Ù Ø§ ÙÙ Ù ÙÙÙ ÙÙا Ù ÙÙÙ Ø ÙÙØÙÙÙ٠عÙ٠اÙÙذب ÙÙÙ ÙعÙÙ ÙÙ)(اÙ٠جادÙØ© 14).</p>
<p>إذاÙØ Ø§Ù٠غضÙب٠عÙÙÙÙ ÙاÙضاÙÙ٠٠٠اÙÙ Ù Ù٠أ٠ÙÙÙÙÙا ٠٠أ٠ÙØ© Ù Ø٠د أ٠عÙس٠أ٠٠ÙسÙ.. أ٠أ٠٠ÙÙØ© أخرÙØ ÙÙ٠غÙر٠٠ØصÙرÙ٠بج٠اعة٠٠ØدÙدة.</p>
<p>اÙÙ ÙاØظة اÙØ£ÙÙ Ù Ù٠أÙÙ ÙÙ٠اÙØ¢Ùات اÙت٠تص٠اÙ٠غضÙب عÙÙÙÙ ÙاÙضاÙÙ٠تتØدث ع٠اÙأخÙا٠ÙاÙسÙÙÙÙØ§ØªØ ÙاÙأخÙاÙÙ Ù٠اÙأساسÙØ ÙاÙشعائر٠اÙدÙÙÙØ© Ø¥Ù Ù٠تÙÙتج٠أخÙاÙا٠٠ع اÙآخر ÙÙ٠٠سÙئة٠ÙÙدÙ٠اÙØ°Ù ÙØÙ ÙÙØ§Ø ÙØ°ÙÙ Ùا٠سبØاÙÙ ÙتعاÙÙ:(أرأÙت٠اÙØ°Ù ÙÙØ°Ùب باÙدÙÙÙ..)Ø ÙÙ ÙÙÙÙ: باÙإسÙا٠أ٠باÙ٠سÙØÙØ©Ø Ø«Ù Ø°Ùر٠صÙات٠إÙساÙÙØ© أخÙاÙÙØ©: (ÙØ°Ù٠اÙØ°Ù Ùدع٠اÙÙتÙÙ Ø ÙÙا ÙØض٠عÙ٠طعا٠اÙ٠سÙÙÙ)(اÙ٠اعÙÙ 2). Ùب٠ÙاØظة عدد Ø¢Ùات اÙعبادات Ù٠اÙÙرآ٠ÙجدÙا 130 Ø¢ÙØ©Ø Ù Ù Ø£ØµÙ 6236 Ø¢ÙØ©Ø Ø¨Ù Ø¹Ø¯ÙÙ Ùسبة 2% بÙÙ٠ا Ø¢Ùات اÙأخÙا٠عددÙا Ù٠اÙÙرآ٠1504 Ø¢ÙØ§ØªØ Ø¨Ù Ø¹Ø¯Ù 24%Ø Ù٠٠ا سبÙÙ Ùجد Ø£Ù٠اÙ٠غضÙب٠عÙÙÙÙ ÙاÙضاÙÙ٠صÙة٠أخÙاÙÙØ© Ùا عÙائدÙØ©Ø ÙÙÙا اÙÙ Ø´ÙÙØ©Ø Ù٠ا Ø£ÙÙا صÙØ©Ù ÙÙست Ø¯Ø§Ø¦Ù Ø©Ø Ø¨Ù Ùاز٠ة ÙÙÙ ÙصÙ٠بÙا ٠ا دا٠اÙÙعÙÙ Ùاز٠ا٠ÙسÙÙÙÙØ ÙتÙتÙ٠اÙصÙة٠عÙ٠باÙØ¥ÙÙاع عÙÙا.</p>
<p> ;</p>
<p>Ùا تÙجد٠Ù٠اÙÙرآ٠إطÙاÙا٠دعÙØ©Ù ÙÙراÙÙØ© اÙÙÙÙد ÙاÙÙصارÙØ Ù٠ا Ùا ÙÙجد٠إطÙاÙا٠Ùضع٠٠ÙÙÙØ©Ù ÙÙÙÙا Ù٠سÙÙØ© ÙاØØ¯Ø©Ø ÙÙÙس٠ع ٠اذا Ùا٠اÙÙرآ٠ع٠اÙÙÙÙد: (ÙÙØ·ÙعÙاÙÙ Ù٠اÙأرض أ٠٠اÙØ Ù ÙÙ٠اÙصاÙØÙÙØ ÙÙ ÙÙ٠دÙÙ Ø°ÙÙ)(اÙأعرا٠168)Ø Ø§ÙظرÙا Ù٠أدبÙات اÙÙرآ٠اÙج٠ÙÙØ©. ÙعÙد٠ا تØدÙØ« ع٠اÙ٠سÙØÙØ© ÙاÙ: (ÙÙتجدÙ٠أÙربÙÙ Ù ÙدÙØ©Ù ÙÙØ°Ù٠آ٠ÙÙا اÙØ°ÙÙ ÙاÙÙا Ø¥ÙÙا ÙصارÙØ Ø°Ù٠بأÙÙ Ù ÙÙÙ ÙسÙسÙÙ ÙرÙباÙا٠ÙØ£ÙÙÙ Ùا ÙستÙبرÙÙ)(اÙ٠ائدة 82). Ùذا باÙÙتÙجة ÙعÙ٠أÙ٠اÙ٠غضÙب٠عÙÙÙÙ ÙاÙضاÙÙÙ Ùد ÙÙÙÙÙا ٠٠أ٠٠ÙÙØ©Ù.</p>
<p>بÙÙت ٠سأÙØ©: Ù٠اÙÙÙÙد٠ÙاÙÙصار٠ÙÙÙار٠باÙÙسبة ÙÙا Ù٠سÙÙ ÙÙØ ÙÙÙÙ٠اÙجÙاب٠ÙØ°Ù٠٠٠اÙÙرآ٠Ùا ٠٠عÙدÙØ Ø¢ÙتÙ٠رب٠ا آخر ٠ا Ùز٠٠٠اÙÙرآÙØ Ù٠اÙبÙرة ÙاÙ٠ائدة: ( Ø¥Ù٠اÙØ°Ù٠آ٠ÙÙا ÙاÙØ°ÙÙ ÙادÙا ÙاÙÙصار٠ÙاÙصابئÙÙØ Ù Ù Ø¢Ù Ù Ø¨Ø§ÙÙÙ ÙاÙÙÙ٠اÙØ¢Ø®Ø±Ø Ùع٠Ù٠صاÙØاÙØ ÙÙÙ٠أجرÙ٠عÙد ربÙÙÙ Ø ÙÙا Ø®ÙÙ٠عÙÙÙÙ ÙÙا ÙÙ ÙØزÙÙÙ )(اÙبÙرة 62)Ø ÙÙ٠تØاسب٠آخر ÙØ£Ù٠٠ختÙÙ٠٠ع٠عÙائدÙاÙ! إذ٠أÙت تتأÙÙ٠عÙ٠اÙÙÙ ÙتخاÙ٠اÙÙرآÙ- اÙÙائÙ: ( Ø¥Ù٠اÙØ°Ù٠آ٠ÙÙا ÙاÙØ°ÙÙ ÙادÙا ÙاÙصابئÙÙ ÙاÙÙصار٠ÙاÙ٠جÙس ÙاÙØ°Ù٠أشرÙÙا Ø¥Ù٠اÙÙÙÙ ÙÙصÙ٠بÙÙÙÙ ÙÙ٠٠اÙÙÙØ§Ù Ø©Ø Ø¥Ù٠اÙÙÙ٠عÙÙ ÙÙÙ Ø´ÙØ¡Ù Ø´ÙÙد)(اÙØج 17)Ø Ùا أ٠تÙصÙ٠أÙت بÙÙÙÙ .</p>
<p>ÙÙ Ùذا اÙسÙاÙØ ÙØضرÙÙ Ù Ùتبس٠٠٠Ùتاب (اÙذات اÙجرÙØØ©)- اÙدÙتÙر اÙعراÙ٠سÙÙÙ Ù Ø·Ø±Ø ØÙØ« Ùتب : &#8221; Ø¥Ù٠اÙداÙع٠اÙØ£ÙÙ ÙÙجÙØ¡ Ø¥Ù٠اÙدÙتاتÙرÙØ© ÙØ£Ù٠سÙطة جدÙدة Ù٠ضعÙ٠اÙÙاعدة اÙاجت٠اعÙØ© ÙÙÙئة اÙØاÙÙ Ø©Ø Ø¨Ø³Ø¨Ø¨ اÙاعت٠اد عÙ٠أÙÙÙØ© Ùا ت٠ث٠إÙا جزءا٠٠٠اÙØ´Ø¹Ø¨Ø Ù Ø«Ù ØªØ¬Ù Ùع عشائر٠أ٠طائÙ٠أ٠دÙÙ٠أ٠٠ÙاطÙ٠أ٠سÙاس٠أÙدÙÙÙÙجÙ.. Ø£Ù ÙÙÙا ٠عاÙ.</p>
<p>Ù٠٠أج٠تعÙÙض ضع٠اÙÙاعدة اÙاجت٠اعÙØ© ÙÙسÙطة Ùت٠اÙاعت٠اد٠عÙ٠اÙأجÙزة اÙØ£Ù ÙÙØ© ÙاÙØزبÙØ© اÙÙ٠عÙØ©Ø ÙبÙدر ٠ا تت٠Ù٠اÙدÙÙØ© ٠٠ت٠ثÙ٠٠ختÙ٠اÙÙئات اÙدÙÙÙØ© ÙاÙÙغÙÙØ© ÙاÙÙ ÙاطÙÙØ© ÙاÙأثÙÙØ©Ø Ø¨Ùدر ٠ا تضطر بدرجة Ø£ÙÙ Ùاستع٠ا٠اÙÙÙØ© Ù٠دÙÙ ÙÙ Ø© سÙطتÙا</p>
<p>Ø¥Ù٠اÙدÙÙ ÙراطÙØ© Ùا تÙÙ٠إÙا Ù٠اÙدÙÙØ© اÙÙÙÙØ©Ø ÙÙا تÙÙ٠اÙدÙÙØ© ÙÙÙØ© Ø¥Ùا ب٠د٠ÙدرتÙا عÙ٠ت٠ثÙ٠أÙسع Ùاعدة Ù Ù Ùئات اÙÙØ·ÙØ ÙاÙدÙÙØ© Ùا ÙÙ ÙÙÙا أ٠ت٠ث٠ÙÙ٠تÙÙعات اÙ٠جت٠ع ٠٠دÙ٠ا٠تÙا٠أساس٠(ÙÙر٠تارÙخ٠تربÙÙ) ÙØ·ÙÙ Ùشا٠٠٠تÙ٠عÙÙÙ Ù Ù Ùب٠ج٠Ùع Ùذ٠اÙتÙÙØ¹Ø§ØªØ Ù Ù٠ا اختÙÙت ÙÙاعاتÙا Ù٠شارÙعÙا اÙسÙاسÙØ©.</p>
<p>Ù٠٠دÙÙ ÙÙÙØ© ÙØ·ÙÙØ© Ù ÙØدة Ùا ÙÙ Ù٠أ٠تÙجد دÙÙØ© ÙØ·ÙÙØ© Ù ÙØØ¯Ø©Ø ÙØ¥Ùا ÙØ¥Ù٠اÙعÙÙ٠اÙبÙÙÙس٠ÙاÙØرÙب اÙخارجÙØ© Ù٠اÙÙسÙÙØ© اÙÙØÙدة ÙدÙÙ ÙÙ Ø© اÙدÙÙØ© اÙت٠Ùا تستÙد عÙÙ ÙÙÙØ©Ù ÙØ·ÙÙØ© ٠تÙا٠ÙØ© Ù ÙØدة.</p>
<p>Ø¥Ù٠اÙØاجة٠ÙبÙاء ÙÙÙØ©Ù ÙØ·ÙÙØ© Ù ÙØدة ÙÙ Øاجة Ø¥ÙساÙÙØ© Ù ÙØÙØ©Ø ÙØ£ÙØ© ٠ج٠Ùعة Ùا ÙÙ Ù٠أ٠ت٠ض٠ØÙاتÙا تعÙØ´ Ù٠رÙعة ÙاØدة Ùتشتر٠Ù٠تÙاصÙ٠اÙØÙاة اÙÙÙÙ ÙØ© ٠٠دÙÙ Øد٠أدÙ٠٠٠اÙشعÙر باÙاÙت٠اء ÙÙ Ø«Ù٠أ٠ÙÙرة ٠شترÙØ©Ø ÙÙÙس ÙÙا٠Ùرد٠أ٠ج٠اعة Ùختار Ø·ÙاعÙØ© عد٠٠اÙارتباط ببÙاد٠ÙأبÙاء بÙادÙ. Ø¥Ù٠أ٠ر٠Ùاس٠Ù٠تعب أ٠تشعر٠باÙاغتراب ع٠أÙاس٠تتعاÙØ´ ٠عÙÙ ÙÙÙ ÙÙÙ Ù ÙتشارÙÙ٠اÙأرض٠ÙاÙÙÙاء ÙاÙ٠اء ÙاÙس٠اء. &#8221;</p>
<blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="e6AMqvTCxp"><p><a href="https://alshamsnews.com/2024/12/30/%d9%86%d9%82%d9%84%d8%aa%d9%87%d9%85-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d9%8a%d8%a7-%d9%84%d9%82%d9%88%d8%a7%d8%b9%d8%af%d9%87%d8%a7-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d9%87%d9%84-%d9%8a%d9%86/">ÙÙÙتÙ٠رÙسÙا ÙÙÙاعدÙا خارج سÙرÙا..ÙÙ ÙÙض٠ÙÙادات جÙØ´ اÙأسد Ù٠رتزÙØ© ÙاغÙر Ø</a></p></blockquote>
<p><iframe class="wp-embedded-content" sandbox="allow-scripts" security="restricted" style="position: absolute; visibility: hidden;" title="&#8220;ÙÙÙتÙ٠رÙسÙا ÙÙÙاعدÙا خارج سÙرÙا..ÙÙ ÙÙض٠ÙÙادات جÙØ´ اÙأسد Ù٠رتزÙØ© ÙاغÙر Ø&#8221; &#8212; اÙش٠س ÙÙÙز" src="https://alshamsnews.com/2024/12/30/%d9%86%d9%82%d9%84%d8%aa%d9%87%d9%85-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d9%8a%d8%a7-%d9%84%d9%82%d9%88%d8%a7%d8%b9%d8%af%d9%87%d8%a7-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d9%87%d9%84-%d9%8a%d9%86/embed/#?secret=bKHQrzfO7d#?secret=e6AMqvTCxp" data-secret="e6AMqvTCxp" width="600" height="338" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe></p>

وإيه يعني نبدأ من الصفر؟
<p>سارة ٠جدÙ</p>
<p>ÙÙ ØÙاة ÙÙ ÙاØد ÙÙÙا ÙØظة بÙÙÙ ÙÙÙا ÙÙسأ٠ÙÙسÙ: &#8220;Ù٠د٠اÙÙ٠أÙا عاÙزÙØ&#8221; ساعات اÙإجابة بتÙÙÙ ÙØ£. ساعات بÙØس إ٠اÙÙÙ Ùات Ùا٠٠جرد برÙÙØ©Ø ÙØ¥ÙÙا Ù ØتاجÙÙ ÙعÙد اÙÙ Ø´Ùد ÙÙ٠٠٠اÙØ£ÙÙ.<br />
بس بÙÙ&#8230; ÙØ¥ÙÙ ÙعÙÙØ ÙØ¥ÙÙ ÙعÙÙ Ùبدأ ٠٠اÙصÙØ±Ø Ø§ÙبداÙات اÙجدÙدة Ù Ø´ ضع٠ÙÙا ÙرÙØ¨Ø Ø¯Ù Ø¬Ø±Ø£Ø©Ø ÙÙØ©Ø ÙخطÙØ© Ø£ÙÙ٠عشا٠ÙعÙØ´ اÙØÙاة اÙÙÙ ÙستØÙÙا.<br />
اÙبداÙØ©: Ùرصة Ù Ø´ عÙاب<br />
اÙبداÙØ© اÙجدÙدة داÙÙ Ùا بتخÙÙ. ÙØ£ÙÙ ÙاÙÙ Ùدا٠بØر ÙبÙر ÙÙ Ø´ عار٠اÙÙ Ùا٠د٠داÙÙØ© ÙÙا ساÙØ¹Ø©Ø Ø³ÙÙØ© ÙÙا ÙÙÙا Ø£Ù Ùاج. بس ÙÙ ÙضÙت ÙاÙÙ Ù ÙاÙÙØ Ø¹Ù Ø±Ù Ù Ø§ ÙتعرÙ. اÙÙ Ø´ÙÙØ© Ù Ø´ Ù٠إÙÙ ØªØ¨Ø¯Ø£Ø Ø§ÙÙ Ø´ÙÙØ© اÙØÙÙÙÙØ© Ù٠إÙ٠تÙض٠ÙاÙ٠٠تردد.<br />
&#8220;اÙبداÙØ© Ù Ø´ ÙرÙب ٠٠اÙ٠اضÙØ Ø¯Ù Ø¥Ø¹Ùا٠إÙÙ Ù Ø´ ٠ستعد تستسÙÙ .&#8221;</p>
<h2>ÙÙ Øاجة جدÙدة بتبدأ بخطÙØ©</h2>
<p>ÙÙÙر ÙدÙØ ÙÙ Øاجة ÙÙ ØÙات٠بدأتÙا بخطÙØ© ÙاØدة. Ø£Ù٠٠رة اتعÙ٠ت ت٠شÙØ Ø£Ù٠٠رة رÙبت عجÙØ©Ø ÙØ£Ù٠٠رة جربت Øاجة ÙÙت خاÙÙ Ù ÙÙا. اÙبداÙات اÙجدÙدة ز٠Ùد٠باÙظبط. اÙخطÙØ© اÙØ£ÙÙÙ ØµØ¹Ø¨Ø©Ø Ø¨Ø³ بعد Ùد٠ÙÙ Øاجة بتتزبط.<br />
&#8220;أصعب خطÙØ© Ù٠أ٠رØÙØ© Ù٠أÙ٠خطÙØ©&#8230; بس برض٠Ù٠أÙ٠خطÙØ©.&#8221;</p>
<h2>اÙ٠اض٠٠ش ØÙ Ù.. Ù٠درس</h2>
<p>ÙÙ ÙاØد ÙÙÙا شاÙ٠٠عا٠شÙÙØ© تجارب ØµØ¹Ø¨Ø©Ø Øاجات تعبت٠أ٠ÙسرتÙ. بس Ù ÙÙ Ùا٠إ٠اÙ٠اض٠Ùاز٠ÙÙض٠شبØØ Ø¥ØÙا Ù Ø´ ٠طاÙبÙÙ ÙÙ Ø³Ø Ø§Ù٠اضÙØ Ø¥ØÙا ٠طاÙبÙÙ ÙتعÙÙ Ù ÙÙ. أ٠درس ٠ر بÙÙ ÙÙ ÙÙطة ÙÙر Ù٠طرÙ٠جدÙد Ùترس٠٠بÙÙسÙ.<br />
&#8220;٠اÙÙØ´ Øاجة اس٠Ùا ÙØ´ÙØ ÙÙÙ Øاجة اس٠Ùا: Ø£Ùا اتعÙ٠ت Ù٠اÙÙÙعش Ø£Ùرر اÙغÙØ· تاÙÙ.&#8221;</p>
<h2>اÙبداÙات اÙجدÙدة: ÙÙØØ© ترس٠Ùا بإÙدÙ</h2>
<p>تخÙ٠إÙ٠رسا٠ÙاÙÙ Ùدا٠ÙÙØØ© ÙاضÙØ©Ø Ù٠س٠Ùرشة اÙØ£ÙÙاÙ. ÙÙ ÙÙÙ ÙتØØ·Ù ÙÙ ÙØ±Ø§Ø±Ø ÙÙ٠خط Ù٠خطÙØ©. اÙÙÙØØ© د٠٠ش ÙتÙÙÙ Ùا٠ÙØ© ٠٠أÙÙ Ù Ø±Ø©Ø Ø¨Ø³ ٠ع ÙÙ Ù٠سة ÙتÙاÙÙ ÙÙس٠أÙرب ÙÙصÙرة اÙÙÙ ÙÙ Ø®ÙاÙÙ.<br />
&#8220;Ù Ø´ Ùاز٠تÙÙ٠اÙبداÙØ© ٠ثاÙÙØ©Ø Ø§ÙÙ Ù٠إÙÙا تÙÙÙ ØÙÙÙÙØ©.&#8221;</p>
<h2>ÙاÙØ®ÙÙØ</h2>
<p>آ٠اÙØ®ÙÙ Ù ÙجÙØ¯Ø Ø¯Ù Ø·Ø¨ÙعÙ. ÙÙÙا بÙخا٠٠٠اÙ٠جÙÙÙØ Ù Ù Ø§ÙغÙØ·Ø ÙÙ Ù ÙÙا٠اÙÙاس. بس اس٠عÙÙ ÙدÙ: اÙÙاس اÙÙ٠بÙتÙÙÙ ÙØ§Ø Ù٠ا ÙÙسÙ٠اÙÙÙ Ù Ø´ عارÙÙÙ ÙتØرÙÙا. ÙØ£ÙØªØ Ø£Ùت اÙÙÙ Ùررت تتØرÙØ Øت٠ÙÙ ÙÙت خاÙÙ.<br />
&#8220;اÙØ®ÙÙ Ù Ø´ عÙØ¨Ø Ø§ÙعÙب Ø¥Ù٠تسÙب٠ÙÙ Ùع٠تعÙØ´ ØÙاتÙ.&#8221;</p>
<h2>Ù Ø´Ùد اÙÙÙاÙØ©: Ùس٠بعÙد</h2>
<p>اÙأج٠٠Ù٠اÙبداÙات اÙجدÙدة Ø¥ÙÙا ٠اÙÙاش ÙÙاÙØ©. داÙÙ Ùا ÙتÙاÙÙ ÙÙس٠بتتعÙÙ Øاجة جدÙØ¯Ø©Ø Ø¨ØªØ§Ø®Ø¯ Ùرار جدÙØ¯Ø ÙبتÙتب ٠شاÙد Ø£ØÙÙ ÙÙ ÙصتÙ. اÙبداÙات د٠Ù٠اÙطرÙÙØ© اÙÙ٠بÙÙÙ٠بÙÙا: Ùس٠عÙد٠ÙتÙر أعÙØ´Ù Ùأع٠ÙÙ.<br />
&#8220;اÙØÙاة Ù Ø´ ÙÙÙÙ ÙÙÙ ÙÙاÙØ© Ù ØØ¯Ø¯Ø©Ø Ù٠سÙسÙØ© ØÙÙات Ø£Ùت اÙÙ٠بتÙتبÙا.&#8221;</p>
<h2>اÙÙÙرة ÙÙÙا</h2>
<p>اÙÙÙرة Ù Ø´ Ù٠إÙ٠تÙÙ٠عار٠اÙطرÙÙ ÙÙÙØ Ø§ÙÙÙرة Ø¥Ù٠تبدأ. Ø®ÙÙ٠٠ر٠٠ع ÙÙسÙØ ØµØ¯Ù Ø¥Ù٠تستØÙ Ùرصة جدÙØ¯Ø©Ø ÙابÙ٠اÙØÙاÙØ© اÙÙ٠تÙÙ٠بÙÙ.<br />
&#8220;ÙØ¥ÙÙ ÙعÙÙ Ùبدأ ٠٠اÙصÙرØ&#8221; اÙج٠ÙØ© د٠٠ش بس عÙÙاÙØ Ø¯Ù Ø´Ø¹Ø§Ø± ÙØÙات٠اÙجدÙدة. اÙتÙر داÙÙ Ùا:<br />
&#8220;Ø£Ùت Ù Ø´ اÙصÙØ±Ø Ø£Ùت اÙبداÙØ©.&#8221;</p>

إنها آخرُ ليلةٍ في هذه السنة..أريدكم أن تستكردوني أكثر، فأنا لا زلتُ كردياً
<p><strong>سÙÙ٠ا٠٠ØÙ Ùد</strong></p>
<p>ÙØ´Ùع٠Ù٠بÙاد ٠صر٠ÙاÙشا٠ÙاÙعرا٠استع٠اÙÙ ÙÙÙ Ø©( اÙاستÙراد )Ø ÙتداÙÙÙا اÙعا٠ة٠ÙÙتعبÙر ع٠٠ÙÙÙ٠أ٠ØاÙ. ÙÙÙÙ Ùثبت٠اÙ٠رء٠ÙÙ Ùذ٠اÙبÙاد Ø£ÙÙ ÙÙس غبÙا٠أ٠بÙÙÙÙاÙØ ÙÙ ØدÙث٠أ٠٠جÙس٠أ٠٠عا٠ÙØ©Ø ÙÙÙظÙا عÙÙاÙ: (Ø£Ùا Ùست٠ÙردÙاÙ). Ùإذا أراد اÙÙاØد٠أ٠Ùثبت٠ÙÙآخر Ø£ÙÙ Ø°ÙÙ ÙÙÙس Ø£ØÙ Ùا٠Øت٠تÙØ·Ù٠عÙÙ٠اÙØÙÙØ©ÙØ ÙØØ°ÙرÙ٠بÙÙÙÙ: أتستÙردÙÙØ!</p>
<p>اÙاستÙراد٠ÙÙظة٠٠ؤذÙة٠جدا٠ÙÙØ£ÙØ±Ø§Ø¯Ø ÙÙÙ Ùس٠عÙ٠اÙÙاس٠ÙتبرؤÙÙ Ù ÙÙÙ ÙÙثبتÙا Ø£ÙÙÙ ÙÙسÙا بØÙ ÙÙ!</p>
<p>Ø¥ÙÙ ÙÙ٠ة٠اÙاستÙراد- اÙت٠خرجت ٠٠عÙد اÙ٠صرÙÙ٠أÙÙاÙ- ÙاÙت Ù٠بداÙØ© اÙأ٠ر ٠دÙØاÙØ ÙÙÙبا٠ÙÙØ·ÙÙÙ ÙÙ٠جا٠ÙØ© عÙ٠غÙر اÙØ£ÙØ±Ø§Ø¯Ø ØªÙدÙرا٠ÙÙÙ Ù٠باÙغة٠Ù٠اØترا٠ÙÙ . ÙاÙØ£Ùراد٠اÙØ°ÙÙ ØÙÙ Ùا ٠صر٠ÙاÙدÙ٠اÙ٠جاÙرة ÙÙا Ø£Ùا٠اÙسÙطا٠صÙØ§Ø Ø§ÙدÙ٠اÙØ£ÙÙبÙØ Ø§ÙشتÙرÙا باÙعد٠ÙاÙ٠عا٠ÙØ© اÙØسÙØ© ٠ع اÙÙØ§Ø³Ø Ø¹Ù٠أÙ٠اÙØÙÙا٠ÙاÙÙادة ÙبÙÙÙ Ù٠٠جاء بعدÙ٠أÙضا٠٠٠اÙ٠٠اÙÙÙ ÙاÙÙا عÙ٠اÙÙÙÙض Ù Ù Ø°ÙÙØ Ø¨Ø±Ùع اÙضرائب عÙ٠اÙعا٠ة ÙضربÙÙ ÙتعذÙبÙÙ Ø ÙتÙدÙدÙÙ ÙÙØ¥ÙرÙجة اÙØ°ÙÙ ÙÙ ÙÙÙÙا ٠٠عا٠ة اÙ٠سÙÙ Ù٠سÙ٠اÙÙراÙÙØ© ÙاÙرÙض.</p>
<p>اÙØ£Ùراد- إذ ÙÙ ÙتساÙÙÙا ÙÙ Ù ÙاجÙØ© اÙصÙÙبÙÙÙ- ÙاÙت ÙتÙاضعت ÙÙÙسÙÙ Ùعا٠ة اÙÙاس Ù٠٠صر٠ÙغÙرÙا ٠٠اÙأ٠صار اÙت٠ØÙÙ ÙÙا. ÙاÙترÙ٠عÙد اÙÙاس اÙعدÙÙ ÙاÙأخÙا٠اÙØسÙØ© باÙعÙÙا٠اÙÙردÙÙØ Ùظرا٠ÙÙÙ٠اÙØÙÙا٠ÙاÙÙادة٠اÙÙبار Ù٠اÙدÙÙØ© ÙاÙÙا Ø£ÙراداÙØ Ùأسد اÙدÙÙ Ø´ÙرÙÙ ÙصÙØ§Ø Ø§ÙدÙ٠اÙØ£ÙÙب٠ÙÙاض٠اÙÙضاة ÙاÙÙاض٠اÙÙاض٠ÙÙادة٠اÙدÙÙا٠ÙاÙجÙØ´ Ù٠٠عظ٠ÙÙ ÙاÙÙا ÙÙرداÙ.</p>
<p>ÙÙ Ù ÙÙا ÙØ¥Ù٠اÙÙاس٠اÙبسطاء Ù٠٠صر٠ÙاÙÙا Ùجا٠ÙÙ٠اÙشرطة ÙØرÙاس٠اÙسجÙÙ ÙاÙضباط اÙصغار Ù٠اÙجÙØ´ ٠٠اÙ٠صرÙÙ٠بإطÙا٠ÙÙب (اÙÙرد٠)عÙÙÙÙ Ø ÙتبجÙÙÙÙ ÙتعظÙÙ Ù٠عبر٠تشبÙÙÙ٠بطبÙØ© اÙØÙÙا٠ÙاÙأشرا٠Ù٠اÙدÙÙØ©. ÙاÙسبب٠Ù٠أغÙب اÙØ£ÙÙات Ùا٠٠٠أج٠تجÙÙب اÙأذ٠٠٠اÙشرطة ÙØراس اÙسجÙÙØ ÙØ£ØÙاÙا٠Ù٠سبÙÙ ÙÙ٠اÙØاجات.</p>
<p>ÙØÙÙ Ùا٠اÙÙاØد٠ÙØ·ÙÙÙ ÙÙب٠(اÙÙردÙ) عÙ٠أÙ٠شخص٠ÙÙ Ø°Ù٠اÙعÙØ¯Ø Ùا٠ÙعÙ٠ب٠ثابة تشرÙÙÙ ÙÙÙ Ùا٠ÙتعظÙÙ Ù ÙÙشأÙ. ÙÙÙ٠اÙ٠صرÙÙ٠أÙرطÙا Ù٠استع٠ا٠اÙÙ Ø¯Ø ÙرجاÙÙ٠باÙÙص٠اÙÙردÙÙØ Øت٠Ùا٠اÙسارÙÙ ÙاÙÙ ØتاÙÙ ÙاÙزاÙÙ Ù٠٠ارتÙبÙا جرائ٠٠٠ختÙÙØ© ÙتÙسÙÙÙ٠إÙ٠سجÙاÙÙÙÙ ÙشرطتÙ٠أÙا٠ÙعذبÙÙÙ Ø Ø¨Ø¥Ø·Ùا٠اÙÙÙب اÙÙرد٠عÙÙÙÙ : Ø£Ùت٠ÙردÙÙ ÙÙا تظÙÙ . Ø£Ùت٠Ùرد٠أ٠أÙÙ Ø·Ùب٠Ù٠تسا٠Ø.</p>
<p>ÙÙÙ٠اÙشرطة٠ÙØرÙاس٠اÙسجÙ٠اÙØ°ÙÙ ÙاÙÙا ÙصرÙÙ٠عÙ٠إذاÙØ© ÙؤÙاء اÙعذاب ÙاÙضرب ÙاÙÙا ÙردÙÙÙ ÙÙراÙ: (أتستÙردÙÙ)!Ø Ø£Ùا Ùست٠ÙردÙاÙØ ÙسأشبعÙ٠ضرباÙ. ÙÙÙذا ب٠رÙر اÙز٠٠تبدÙÙ٠اÙÙ ÙÙÙ٠٠تدرÙجÙا٠٠٠٠دØ٠إÙÙ ÙدØ. ÙØ£ØµØ¨Ø Ø§ÙÙÙÙÙ (Ø£Ùت٠ÙردÙÙ) ØÙÙØ©Ù ÙÙÙ٠٠را٠٠غÙر Ù ÙبÙÙ. ÙØت٠ÙتخÙÙص اÙ٠سؤÙÙ٠أ٠اÙÙائ٠٠عÙ٠اÙشأ٠٠٠اÙØ¥Øراج Ùا٠ÙجÙب: (Ùا تستÙردÙÙ. Ø£Ùا Ùست٠ÙردÙاÙ). ÙÙÙØ°Ø§Ø Ùرب٠ا ÙسÙØ¡ Øظ٠اÙØ£Ùراد ÙطاÙعÙÙ Ø Ø£ØµØ¨Ø Ø¹ÙÙاÙÙ٠اÙذ٠أÙØ٠باÙ٠جد ÙاÙ٠دÙØ Ø¥ÙÙ ÙÙ٠ة٠٠تداÙÙØ© Ùد٠عا٠ة شعÙب اÙÙ ÙØ·ÙØ©Ø ØªØÙ Ù٠٠عÙÙ٠سÙبÙاÙØ ÙØ°ÙÙ ÙتÙØ·Ùع أسباب ٠عرÙØ© أصÙ٠اÙÙÙÙ Ø© عÙدÙÙ Ø Ø£Ù Ø§Ùجذر اÙØ«ÙاÙÙ ÙÙذ٠اÙشتÙÙ Ø©.</p>
<h2><strong>٠ظÙÙÙ ÙØ© اÙشعب اÙÙردÙ</strong></h2>
<p>Ù ÙاØظة 1: اÙشعب اÙÙرد٠٠٠أÙثر اÙشعÙب ٠ظÙÙÙ ÙØ©Ù Ù٠اÙعاÙÙ . Ùرغ٠ذÙÙ ÙÙ ÙØ°Ùر اÙتارÙØ® Ø£Ù٠اÙØ£Ùراد٠اØتÙÙا أرض٠أØد٠ÙÙتÙسÙعÙا عÙÙ Øساب شعÙب٠أخرÙØ Ø£Ù ÙÙÙÙÙ Ùا بإبادة شعب٠آخر بÙد٠اÙسÙطرة عÙÙÙØ Ù٠ا Ùع٠جÙراÙÙ٠اÙعرب٠ÙاÙÙرس ÙاÙترÙØ Ø§ÙØ°Ù٠ا٠تÙØ£ تارÙØ®Ù٠باÙسÙاد بغرض بÙائÙ٠عÙ٠٠د٠اÙتارÙØ®.<br />
Ù ÙاØظة2: Ø¥Ù٠اÙ٠صرÙÙ٠أÙثر٠٠ÙÙا٠٠٠اÙشعÙب اÙأخر٠إÙ٠اÙÙÙاÙØ© ÙإطÙا٠اÙØ£Ùصا٠عÙ٠اÙج٠ÙØ¹Ø ÙØت٠عÙ٠أÙÙسÙÙ (اÙصعاÙدة Ù Ø«Ùا٠عÙدÙÙ ÙاÙÙÙبÙÙÙ) سخرÙØ©Ù ÙتÙرÙغا٠ÙØ´ØÙات اÙغضب ÙاÙØ¥Øباط اÙÙاتجة ع٠اÙأز٠ات اÙ٠عÙØ´ÙØ© اÙ٠تÙاØÙØ©.</p>
<p>اÙطرÙÙÙ Ù٠اÙأ٠ر Ø£Ù٠طاÙ٠ا استÙرد٠اÙعاÙ٠٠بعض٠اÙبعض Ù ÙØ° ٠ئات اÙسÙÙÙ! ÙÙ ÙØ° 13 عا٠ا٠ÙاÙÙظا٠ÙستÙرد٠اÙشعب٠بÙÙÙÙ: اÙتÙ٠اÙأ٠ر ÙاÙØ£Ù Ùر بخÙØ±Ø ÙاÙ٠عارضة٠تستÙرد٠اÙعاÙ٠بÙÙÙÙا: سÙÙتصر٠بإرادتÙا Ù٠بادئÙا. ÙاÙرÙس٠ÙستÙردÙ٠ترÙÙØ§Ø ÙاÙأتراÙÙ ÙستÙردÙ٠اÙج٠اعات ÙاÙÙصائ٠اÙ٠سÙØØ© بتس٠ÙتÙÙ (اÙجÙØ´ اÙÙØ·Ù٠اÙØرÙ).. ÙاÙآ٠جاء اÙجÙÙاÙÙ ÙÙستÙرد٠اÙج٠Ùع بخارطة طرÙÙ٠اÙإرÙابÙØ©.<br />
Ùب٠ا Ø£Ù٠اÙج٠Ùع٠ÙØاÙÙ٠أ٠ÙستÙرد٠اÙج٠ÙØ¹Ø ÙØ¥Ù٠اÙج٠اÙÙر٠ÙاÙشعب٠اÙسÙر٠Ùد ÙتØÙÙÙÙ Ù٠عا٠2025 Ø¥Ù٠أÙراد!</p>

إيه اللي هتسيبه في 2024؟ وإيه اللي هتاخده معاك في 2025؟
<p>اÙسÙØ© د٠٠ش ٠جرد Ø£Ùا٠بتعدÙØ Ø¯Ù Ùرار&#8230; Ùرار Ø¥Ù٠تÙÙ٠اÙ٠تØÙÙ Ù Ø´ اÙ٠تØÙ٠بÙ. Ùب٠٠ا تستعد ÙÙسÙØ© اÙجدÙدة 2025Ø Ù Øتاج تÙ٠٠ع ÙÙس٠ÙÙÙØ© صادÙØ© ÙتسأÙ: Ø¥Ù٠اÙÙÙ ÙعÙا٠ÙستاÙ٠أÙÙ Ù٠٠عاÙØ§Ø ÙØ¥Ù٠اÙÙÙ Ùاز٠أسÙب٠ÙراÙاØ</p>
<p>Ùات ÙرÙØ© ÙÙÙÙ Ø ÙتعاÙÙ Ùخطط ٠ع بعض:</p>
<h3>• Ø¥Ù٠اÙØ£ÙÙار اÙÙÙ ÙعÙا٠ÙتساعدÙ٠أØÙ٠أÙداÙÙØ</h3>
<p>ÙÙر: Ù٠عÙد٠٠عتÙدات أ٠أÙÙار Ù ÙÙÙاÙØ ÙÙ Ù٠تÙÙ٠اÙÙÙرة د٠ع٠ÙÙس٠أ٠ع٠ÙدراتÙ. Ù٠تستاÙ٠تÙض٠٠ت٠س٠بÙÙاØ<br />
• Ø¥Ù٠اÙ٠شاعر اÙÙÙ Ù ØتاجÙا عشا٠أعÙØ´ ØÙاة Ù ÙÙاÙØ© ÙرØØ© ÙبÙجةØ<br />
ÙÙ Ù٠تÙÙÙ Ù Øتاج تسÙب ٠شاعر اÙØ°ÙØ¨Ø Ø§ÙØ®ÙÙØ Ø£Ù Øت٠اÙضغط اÙ٠ست٠ر. Ùتاخد ٠عا٠شعÙر Øب غÙر ٠شرÙØ· ÙÙÙسÙØ Ùا٠تÙا٠عÙ٠أبسط اÙÙÙع٠.</p>
<blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="8kdCnoASjp"><p><a href="https://alshamsnews.com/2024/12/19/%d9%86%d8%b8%d8%b1%d9%8a%d8%a9-let-them-%d8%b3%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%81%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d9%82%d8%a8%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%8a%d8%a7/">ÙظرÙØ© &#8220;Let Them&#8221;: سر اÙراØØ© اÙÙÙسÙØ© ÙÙبÙ٠اÙØÙاة</a></p></blockquote>
<p><iframe class="wp-embedded-content" sandbox="allow-scripts" security="restricted" style="position: absolute; visibility: hidden;" title="&#8220;ÙظرÙØ© &#8220;Let Them&#8221;: سر اÙراØØ© اÙÙÙسÙØ© ÙÙبÙ٠اÙØÙاة&#8221; &#8212; اÙش٠س ÙÙÙز" src="https://alshamsnews.com/2024/12/19/%d9%86%d8%b8%d8%b1%d9%8a%d8%a9-let-them-%d8%b3%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%81%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d9%82%d8%a8%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%8a%d8%a7/embed/#?secret=E7B0Sbd1j9#?secret=8kdCnoASjp" data-secret="8kdCnoASjp" width="600" height="338" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe></p>
<p>• Ù Ù٠اÙأشخاص اÙÙÙ ÙجÙدÙ٠بÙضÙÙ ÙØÙات٠ج٠اÙØ<br />
اÙعÙاÙات اÙÙ٠بتدÙÙ Ø¯Ø¹Ù Ø ØØ¨Ø Ù٠رØØ Ù Øتاج تØاÙظ عÙÙÙا. أ٠ا اÙعÙاÙات اÙÙ٠بتستÙزÙÙØ ÙÙ ÙÙ Øا٠ÙÙت إعادة تÙÙÙÙ Ùا.<br />
• Ø¥Ù٠اÙÙÙ Ù Øتاج٠Ù٠صØت٠اÙجسدÙØ©Ø<br />
جس٠٠شرÙÙÙ Ù٠رØÙتÙØ ÙÙر Ù٠اÙخطÙات اÙÙÙ ÙتخÙÙ٠أÙثر صØØ© ÙÙÙØ©Ø Ø¹Ø´Ø§Ù ØªÙدر تست٠تع بإÙجازاتÙ.<br />
ÙأخÙراÙØ Ø§Ø³Ø£Ù ÙÙسÙ: Ø£Ùت Ù Ù٠دÙÙÙتÙØ ÙعاÙز تÙÙ٠إÙÙØ<br />
اÙÙØظة اÙØاÙÙØ© Ù٠بداÙØ© رØÙتÙØ Ùرارات٠Ù٠اÙÙÙ ÙتصÙع 2025. Øدد Ø£ÙÙÙÙاتÙØ Ùرر ٠صÙرÙØ Ø§Ø®ØªØ§Ø± اÙÙÙ ÙÙاسبÙØ ÙتجاÙز ÙÙ Øاجة بتعطÙÙ.</p>
<h2>اÙسÙØ© اÙجدÙدة Ù Ø´ ÙدÙØ©Ø ÙÙ Ùرصة&#8230; ÙاÙÙرص بتØتاج شجاعة. Ø¥ÙÙ ÙرارÙØ</h2>
<p> ;</p>
<h3>ابدأ عا٠٠اÙجدÙد بÙÙاء داخÙÙ ÙÙضÙØ</h3>
<p>Ùب٠٠ا تبدأ صÙØØ© جدÙدة ÙÙ 2025Ø Ø®Ø¯ ÙÙت٠تع٠٠ع٠ÙÙØ© &#8220;جرد ÙغربÙØ©&#8221; شا٠ÙØ© ÙÙ٠جÙاÙب ØÙاتÙ. ز٠٠ا بتÙض٠٠ÙاÙÙ Ù٠ا تØس باÙÙÙضÙØ Ù Øتاج تÙض٠ØÙات٠عشا٠تدÙÙا ٠ساØØ© ÙÙأشÙاء اÙجدÙدة ÙاÙ٠بÙجة.<br />
• اجرد Ù Ù ØÙات٠اÙ٠اض٠اÙ٠ؤÙÙ ÙاÙØ°ÙرÙات اÙسÙئة.<br />
Ù ÙÙØ´ داع٠تØبس ÙÙس٠Ù٠أØداث اÙتÙت Ø£Ù ÙØظات Ù ÙÙتش اÙØ£ÙضÙ. سا٠ØØ Ù Ø´ عشا٠اÙÙÙ ØصÙØ ÙÙ٠عشا٠ÙÙس٠تستØ٠تعÙØ´ بسÙا٠.</p>
<h2><a href="https://alshamsnews.com/2024/12/12/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%b9%d9%83%d8%a7%d8%b3/">Ø£Ùت اÙسبب ÙÙ Ù٠اÙÙ٠بÙØصÙÙ&#8230; صد٠أ٠Ùا تصدÙ!</a></h2>
<p> ;</p>
<p>• ابعد ع٠اÙأشخاص اÙ٠ؤذÙÙÙ ÙاÙ٠ستÙزÙÙÙ.<br />
اÙÙÙ Ù Ø´ بÙضÙÙ ÙØÙات٠ØØ¨Ø Ø¯Ø¹Ù Ø Ø£Ù Ø·Ø§ÙØ© Ø¥ÙجابÙØ©Ø ÙجÙدÙ٠عبء Ù Ø´ Ùاز٠تشÙÙ٠٠عا٠اÙسÙØ© اÙجدÙدة.<br />
• Ùظ٠ÙÙض٠ÙÙÙ Ù Ù٠سؤÙÙÙاتÙ.<br />
ÙÙ Ù٠٠سؤÙÙÙات Ù Ø´ بتاعتÙØ ÙÙ٠شاÙÙÙا عشا٠عادات أ٠ضغط ٠٠اÙÙÙ ØÙاÙÙÙØ Øا٠اÙÙÙت تÙÙÙ &#8220;Ùا&#8221;.<br />
• اجرد ÙاتÙÙ.<br />
Ø§Ù Ø³Ø Ø§ÙأرÙا٠اÙÙ٠بÙت ٠صدر تÙتر Ø£Ù ØزÙØ Ø§ÙصÙر ÙاÙÙ Ùاطع اÙÙ٠بتØÙ Ù Ø°ÙرÙات ٠ؤÙÙ Ø©. Ù ÙباÙÙÙ Ù Ø´ Ø£ÙبÙÙ ÙÙ٠اضÙØ Ø®ÙÙ٠أداة ÙبÙاء ٠ستÙبÙÙ.<br />
• اجرد دÙÙابÙ.<br />
اÙÙ Ùابس اÙÙÙ Ù Ø´ بتÙبسÙØ§Ø ÙاÙأشÙاء اÙÙ٠بÙت ٠جرد ØÙÙ ÙØ ØªØ®Ùص Ù ÙÙا. ادÙÙÙ ÙØد ÙستÙÙØ¯Ø ÙاÙØªØ Ù Ø³Ø§ØØ© ÙØ´ÙØ¡ جدÙد ÙÙاسبÙ.<br />
• Ùظ٠ذÙرÙات٠ÙÙÙبÙ.<br />
اÙعÙÙ ÙاÙÙÙب Ù ØتاجÙ٠تÙظÙ٠دÙر٠ز٠أ٠٠ÙاÙ. Ø´Ù٠اÙØ®ÙÙØ Ø´Ù٠اÙØزÙØ Ùابدأ تد٠ÙÙس٠Ùرصة ÙÙØØ¨Ø Ø§ÙØ£Ù ÙØ ÙاÙÙرØØ©.<br />
Ù٠ا ت٠ÙØ£ ÙÙب٠باÙØب ÙاÙا٠تÙاÙØ ÙتشÙ٠اÙÙر٠٠ش بس Ù٠إØساسÙØ ÙÙÙ ÙÙ Ù٠تÙاصÙÙ ØÙاتÙ. ÙتÙاÙÙ ÙÙس٠أÙثر Ø®ÙØ©Ø Ø£Ùثر بÙØ¬Ø©Ø ÙØ£Ùثر استعدادا٠ÙاØتضا٠ÙÙ Øاجة ØÙÙØ© جاÙØ© ÙÙ 2025.<br />
اÙسÙØ© اÙجدÙدة ÙÙ Ùرصت٠تÙÙ٠اÙÙسخة اÙØ£Ùض٠٠٠ÙÙسÙ. اÙÙرار ÙÙÙØ ÙØ£Ùت تستØ٠اÙØ£ÙضÙ.</p>
<h3>Øرر اÙ٠اضÙØ ÙتصÙع ٠ساØØ© ÙÙ٠ستÙبÙ</h3>
<p>Ù٠عÙ٠اÙطاÙØ§ØªØ ÙÙ Ø´ÙØ¡ ØÙÙÙ ÙØ٠٠طاÙØ©Ø Øت٠اÙصÙر اÙÙ٠بÙØ´ÙÙÙا عادÙØ©. اÙصÙر اÙÙÙ Ù٠تÙÙÙÙÙÙØ Ø£ÙبÙ٠ات Ø°ÙرÙاتÙØ ÙØت٠اÙأشÙاء اÙصغÙرة اÙÙ٠تØتÙظ بÙÙا بدÙÙ ÙعÙØ Ù Ù Ù٠تÙÙ٠سبب Ù٠تعطÙ٠طاÙتÙ.<br />
ÙÙر Ù٠دÙ: عاÙز عÙاÙت٠بÙÙس٠أ٠بشخص جدÙد تزدÙØ±Ø ÙÙÙÙ Ùس٠٠اس٠Ù٠صÙر Ø£Ù Ø°ÙرÙات ÙعÙاÙØ© سابÙØ© اÙتÙØªØ Ø¯Ù Ù Ø´ بس بÙربط٠باÙ٠اضÙØ ÙÙÙ٠بÙÙ Ùع اÙ٠ستÙب٠٠٠اÙدخÙÙ ÙØ£Ù٠ببساطة &#8220;٠اÙÙØ´ Ù ÙاÙ..<br />
٠د٠ع٠تجربة..جربÙا بÙÙس٠٠٠ش Ùتصد٠ÙÙسÙØ Ù٠شخص بعد عÙÙ Ùجأة ÙÙرجع ÙÙ٠شخص عاÙز٠ÙÙرب ÙÙÙرب ب٠جرد تخÙÙ٠ع٠اÙ٠اض٠بخطÙØ© بسÙطة..</p>
<h3>دÙر ÙÙ ØÙاتÙ:</h3>
<p>• Ø¥Ù٠اÙØاجة اÙÙ٠٠اس٠ÙÙÙا Ùبت٠Ùع اÙتغÙÙرØ<br />
• ÙÙ٠٠ساØØ© ØÙات٠اÙÙÙ Ù ÙÙاÙØ© ÙÙض٠ÙÙ Øتاجة ترتÙبØ<br />
ÙÙ Ù٠تÙاÙ٠إÙ٠٠جرد خطÙØ© بسÙØ·Ø©Ø Ø²Ù Ù Ø³Ø ØµÙØ±Ø©Ø Ø§Ùتبرع بÙطعة ÙدÙÙ Ø©Ø Ø£Ù Ùتابة صÙØØ© تعبر ÙÙÙا ع٠اÙÙ٠جÙاÙØ Ù Ù Ù٠تخÙ٠تغÙÙر ÙبÙر ÙÙ ØÙاتÙ.</p>
<h3>اسأ٠ÙÙسÙ:</h3>
<p>• Ø¥Ù٠اÙØ´ÙØ¡ اÙÙÙ Ù Ù Ù٠أجرب٠عشا٠أÙØªØ Ø¨Ø§Ø¨ جدÙدØ<br />
• Ø¥Ù٠اÙتغÙÙر اÙبسÙØ· اÙÙÙ Ù Ù Ù٠أع٠Ù٠اÙÙÙØ§Ø±Ø¯Ø©Ø Ø¨Ø³ تأثÙر٠ÙÙض٠٠عاÙا سÙÙÙØ<br />
تذÙØ±Ø Ø§Ù٠اض٠٠ÙاÙÙ ÙراÙØ ÙÙ٠اÙ٠ستÙب٠٠Øتاج٠دÙÙÙتÙ. اØØ°ÙØ ØØ±Ø±Ø Ùابدأ تصÙع ٠ساØØ© ÙÙ٠اÙÙ٠بتØÙ٠بÙÙ. Ùأ٠اÙÙ٠جا٠داÙ٠ا٠بÙستاÙÙ.</p>
<p> ;</p>

نظرية “Let Them”: سر الراحة النفسية وقبول الحياة
<p>سارة ٠جدÙ<br />
Ø£Ùا داÙÙ Ùا ÙÙت بعاÙÙ Ù Ù ÙÙ٠شدÙد ÙتعÙÙ ÙÙسÙطرة عÙ٠أ٠Øاجة ÙÙ ØÙاتÙ..بØاÙ٠اع٠٠اÙØµØ Ù Ø§Ùض٠٠رÙزة عÙ٠اÙÙتÙجة..ÙعÙ٠اشتغ٠Ùاع٠٠اÙÙ٠عÙÙا ٠اØس٠Øاجة ٠استÙ٠ترÙÙØ©Ø Ø§Ø¹Ø§Ù Ù Ø´Ø®Øµ بشÙÙ ÙÙÙس ٠استÙÙ ÙتÙجة ٠عÙÙØ© اÙÙ Ù Ø«Ùا٠ÙÙدرÙÙ Ù Ùعا٠ÙÙ٠بطرÙÙØ© ÙÙ Ø®ÙاÙÙ..<br />
ÙضÙت سÙÙ٠بØاÙ٠اسÙطر Ùعشا٠أÙص٠Ù٠رØÙØ© اÙتسÙÙÙ Ùا٠٠ش ÙÙدر اتØÙÙ ÙÙ ØØ§Ø¬Ø©Ø Ø¨Ùع ÙØ£ÙÙ٠ز٠طÙÙ Ùس٠بÙتعÙ٠اÙÙ Ø´Ù..<br />
ØاÙÙت أتعÙÙ Ùأدرب ÙÙسÙØ ÙÙÙت بÙØ¬Ø Ø£ÙÙات ÙØ£ÙÙات ÙØ£. ÙÙرة Ø¥ÙÙ Ù Ø´ Ù ØبÙبة Ø£Ù Ù Ø´ Ù ÙبÙÙØ© عÙد شخص ÙاÙت عا٠ÙØ© ز٠إØساس تÙÙÙ ÙÙ٠صدر٠ز٠اÙجبÙØ ÙØ®ÙتÙ٠أتعا٠٠٠ع Ù ÙاÙÙ ÙتÙر بطرÙÙØ© أسÙØ£ بسبب Ø¥Ù٠بØاÙ٠داÙÙ Ùا أرض٠اÙÙاس. Ùد٠Øاجة Ù Ø´ ÙØ®Ùرة بÙÙا خاÙص.</p>
<p>Ù٠٠رة Ø´Ùت ÙÙدÙ٠صدÙØ© عÙ٠اÙØ¥Ùستجرا٠ÙÙاتبة اس٠Ùا Ù Ù٠رÙبÙÙز. اÙÙÙدÙÙ Ùا٠ع٠Øاجة اس٠Ùا ÙظرÙØ© &#8220;Let Them&#8221;Ø ÙÙ٠ا Ø´Ùت اÙÙÙدÙÙ ØسÙت Ø¥ÙÙ Ù٠سÙ٠جدÙا. اÙÙظرÙØ© د٠عÙÙت Ù٠د٠اغ٠بطرÙÙØ© Ù Ø´ عارÙØ© Ø£ÙساÙØ§Ø ÙÙ Ù ÙÙتÙا غÙرت ØÙات٠ت٠ا٠Ùا..</p>
<h2>
Ø¥ÙÙ ÙÙ ÙظرÙØ© &#8220;Let Them&#8221;Ø</h2>
<p>Ù Ù٠رÙبÙÙز شرØت اÙÙظرÙØ© بطرÙÙØ© بسÙطة جدÙØ§Ø ÙÙاÙت: &#8220;Ù٠أصØاب٠٠ش عاز٠ÙÙ٠عÙ٠اÙغدا اÙأسبÙع دÙ&#8230; سÙبÙÙ .<br />
Ù٠اÙشخص اÙÙ٠٠عجبة بÙÙ Ù Ø´ عاÙز Ùدخ٠Ù٠عÙاÙØ© جدÙØ©&#8230; سÙبÙÙ.&#8221; اÙÙ ÙضÙع Ø´ÙÙ٠بسÙØ· جدÙا Ù٠اÙØ£ÙÙØ Ø¨Ø³ Ù٠ا تÙÙر ÙÙÙ Ø¨Ø¬Ø¯Ø Ù Ø´ سÙÙ Ù٠اÙتطبÙÙØ Ø®ØµÙصÙا ÙÙ ÙÙت زÙÙ..</p>
<blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="GLdAeP1BZR"><p><a href="https://alshamsnews.com/2024/12/12/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%b9%d9%83%d8%a7%d8%b3/">إزا٠بتصÙع ٠شاÙÙ٠بإÙدÙÙØ Ø§ÙØÙÙÙØ© اÙصاد٠ة ÙÙاÙÙ٠اÙاÙعÙاس!</a></p></blockquote>
<p><iframe class="wp-embedded-content" sandbox="allow-scripts" security="restricted" style="position: absolute; visibility: hidden;" title="&#8220;إزا٠بتصÙع ٠شاÙÙ٠بإÙدÙÙØ Ø§ÙØÙÙÙØ© اÙصاد٠ة ÙÙاÙÙ٠اÙاÙعÙاس!&#8221; &#8212; اÙش٠س ÙÙÙز" src="https://alshamsnews.com/2024/12/12/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%b9%d9%83%d8%a7%d8%b3/embed/#?secret=oIkB2NLNZh#?secret=GLdAeP1BZR" data-secret="GLdAeP1BZR" width="600" height="338" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe></p>
<p>اÙÙÙرة اÙأساسÙØ© Ø¥ÙÙا بÙضÙع ÙÙت Ù٠جÙÙد ÙبÙر عشا٠ÙØاÙÙ ÙØ®Ù٠اÙÙاس ÙتصرÙÙا باÙطرÙÙØ© اÙÙ٠إØÙا عاÙزÙÙÙا.<br />
اÙÙظرÙØ© بتÙÙ٠إÙ٠تسÙبÙÙ ÙتصرÙÙا عÙ٠طبÙعتÙÙ . اÙÙاس Ùتبا٠عÙÙ ØÙÙÙتÙÙ Ù Ù Ø®Ùا٠تصرÙاتÙÙ Ø ÙاÙت Ù Ø´ Ù Øتاج تع٠٠Øاجة غÙر Ø¥ÙÙ &#8220;تسÙبÙÙ &#8221;. اÙÙرار اÙÙ٠بجد بÙÙÙ٠عÙد٠Ù٠إÙت Ùتتصر٠إزا٠تجا٠دÙ.</p>
<h2>
اÙÙظرÙØ© د٠بتشتغ٠إزاÙØ</h2>
<p>غÙÙرÙا زاÙØºØ Ù Ø¹Ø§Ùجة ÙÙسÙØ© ÙÙ Ùد٠ة برÙا٠ج &#8220;The Inner Child Podcast&#8221;Ø ÙاÙت إ٠اÙÙظرÙØ© د٠بتخÙÙÙا ÙتØرر ٠٠٠سؤÙÙÙØ© Ø¥ÙÙا ÙØاÙÙ ÙسÙطر عÙÙ Øاجات برا Ùطا٠تØÙÙ Ùا. ÙØ£Ùدت Ø¥Ù٠ع٠ر٠٠ا تÙدر تجبر Øد Ùتصر٠بطرÙÙØ© Ù Ø´ عاÙزÙا. ÙÙÙ ØاÙÙØªØ Ø§ÙÙتÙجة داÙÙ Ùا ÙتÙÙÙ Ø®ÙÙ Ùزع٠أÙتر.<br />
اÙÙÙا٠د٠Ù٠سÙ٠جدÙØ§Ø Ø®ØµÙصÙا Ø¥ÙÙ ÙضÙت ÙÙت Ø·ÙÙÙ ÙÙ ØÙات٠بÙÙر ÙÙ Ùرارات٠بÙاء٠عÙ٠رد Ùع٠اÙÙØ§Ø³Ø Ùد٠خÙاÙ٠أÙس٠أÙا أصÙا٠عاÙزة Ø¥ÙÙ.<br />
اÙÙÙرة بسÙطة جدÙا: Ù Ø´ ÙتÙدر تتØÙÙ Ù٠اÙÙØ§Ø³Ø Ùا Ø£ÙعاÙÙÙ ÙÙا ÙÙا٠ÙÙ ÙÙا تصرÙاتÙÙ . اÙØاجة اÙÙØÙدة اÙÙ٠تÙدر تتØÙÙ ÙÙÙا Ù٠اÙت.</p>
<h2>اتعÙ٠تسÙب اÙÙاس ÙبÙÙا Ù٠ا &#8220;ÙÙسÙÙ &#8221;</h2>
<p>اتعÙ٠ت Ø¥ÙÙ Ùاز٠أÙب٠اÙÙاس عÙÙ ØÙÙÙتÙÙ Ø Ø³Ùاء ÙاÙÙا ز٠٠ا بØبÙ٠أ٠Ùا. داÙÙ Ùا ÙÙت Øاسة بضغÙØ· Ø¥Ù٠أعÙØ´ باÙØ´Ù٠اÙÙ٠اÙÙاس ٠تÙÙعا٠٠ÙÙØ Ùد٠خÙاÙ٠أطب٠ÙÙس اÙضغط عÙ٠اÙÙاس اÙÙÙ ØÙاÙÙا.<br />
بÙÙت أسأ٠ÙÙس٠سؤا٠٠ÙÙ : &#8220;Ù٠أÙا بتعا٠٠٠ع اÙشخص د٠عÙÙ ØÙÙÙتÙØ ÙÙا عÙ٠اÙصÙرة اÙÙ٠أÙا عاÙزاÙاØ&#8221; Ù٠اÙإجابة إ٠د٠ع٠اÙصÙرة اÙÙÙ Ù٠د٠اغÙØ Ø¨Ø¹Ø±Ù Ø¥Ù Ø¯Ù ÙÙت Ø¥Ù٠أعÙد اÙتÙÙÙر ÙÙ ÙÙسÙ.<br />
Ù٠٠ا أرÙز Ø£Ùتر عÙÙ ÙبÙ٠اÙÙاس Ù٠ا ÙÙ Ø§Ø Ø¨Ø´ÙÙÙÙ ÙبشÙÙ ÙÙس٠بÙضÙØ Ø£Ùتر&#8230; Øت٠Ù٠د٠٠عÙا٠إ٠اÙØÙÙÙØ© Ù Ø´ داÙÙ Ùا ج٠ÙÙØ©.</p>
<h2>
إزا٠اÙÙظرÙØ© غÙرت عÙاÙاتÙØ</h2>
<p>Ø£Ù Ù٠٠أ٠تطÙر بÙج٠داÙÙ Ùا ٠ع Ø¥Øساس بعد٠اÙراØØ©Ø Ùد٠٠ش Øاجة جدÙدة. Ù٠ا بÙاج٠ØÙÙÙØ© أ٠شخص ز٠٠ا ÙÙØ Ø¨Ùدر أع٠٠Ùرارات Ø£Ùع٠ع٠ÙÙس٠Ùع٠ÙÙعÙØ© اÙÙاس اÙÙ٠أÙا عاÙز Ø£ØÙØ· ÙÙس٠بÙÙÙ . ÙظرÙØ© &#8220;Let Them&#8221; أجبرتÙ٠أرÙز عÙÙ ÙÙسÙ: إزا٠بتعا٠٠٠ع اÙÙ ÙاÙ٠اÙÙ٠بتضغطÙÙØ ÙØ¥Ù٠أÙ٠اط اÙتÙÙÙر اÙÙ٠بتتÙرر عÙدÙØ ÙاÙÙ Ùاط٠اÙÙÙ Ù Øتاجة تØسÙÙ ÙتطÙÙر.<br />
رÙبÙÙز بتس٠٠د٠&#8220;Ø٠اÙØ© اÙسÙا٠اÙعاطÙÙ&#8221;Ø ÙاÙÙظرÙØ© Ù٠ا٠بتخÙÙÙ٠أبعد ع٠اÙتدخ٠ÙÙ ØÙاة اÙÙاس ÙأرÙز Ø£Ùتر عÙÙ ØÙاتÙ. Ø£Ùا Ù Ø´ ٠ثاÙÙØ©Ø Ø¨Ø³ بÙÙت Ø£Ø³Ù Ø ÙÙÙس٠أغÙØ·Ø ÙأسÙب اÙÙÙ ØÙاÙÙا ÙغÙØ·Ùا ÙÙ Ù٠اÙ. ببطÙ٠أØاÙ٠أسÙطر عÙ٠آراء اÙÙاس ÙÙراراتÙÙ . ÙاÙØ£ÙÙ Ù Ù Ù٠دÙØ Ø¨ÙÙت Ø£Ùب٠اÙØÙاة عÙÙ ØÙÙÙتÙØ§Ø ÙÙ ÙÙ ÙÙاØÙ ØÙاتÙ.</p>
<blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="9RTKDQ3Wp1"><p><a href="https://alshamsnews.com/2024/12/05/%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%a8-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b2%d9%88%d8%a7%d8%ac-%d9%85%d8%a7-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b2%d9%85%d8%a9-%d8%a8%d9%80-%d8%a7%d9%84%d8%a7/">بÙ٠اÙØب ÙاÙزÙاج..٠ا عÙاÙØ© اÙجز٠ة ب٠اÙاÙس</a></p></blockquote>
<p><iframe class="wp-embedded-content" sandbox="allow-scripts" security="restricted" style="position: absolute; visibility: hidden;" title="&#8220;بÙ٠اÙØب ÙاÙزÙاج..٠ا عÙاÙØ© اÙجز٠ة ب٠اÙاÙس&#8221; &#8212; اÙش٠س ÙÙÙز" src="https://alshamsnews.com/2024/12/05/%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%a8-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b2%d9%88%d8%a7%d8%ac-%d9%85%d8%a7-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b2%d9%85%d8%a9-%d8%a8%d9%80-%d8%a7%d9%84%d8%a7/embed/#?secret=EIVs9j3z7v#?secret=9RTKDQ3Wp1" data-secret="9RTKDQ3Wp1" width="600" height="338" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe></p>
<p> ;</p>
<p>٠ساعات بضع٠٠بØاÙ٠أÙÙ٠اÙÙÙ ÙÙت ٠تÙÙعا٠٠٠اÙشخص اÙÙ٠خذÙÙÙ..بس برجع اÙÙر ÙÙس٠ا٠اÙشخص اÙتاÙ٠اختار اÙاختÙار د٠بÙاء عÙ٠تÙÙÙر٠٠تÙدÙر٠ÙÙ Ø´ ÙÙدر اغÙر د٠Øت٠ÙÙ ÙاجعÙÙ..ÙبسÙبÙ. بسÙب اÙشخص Ùتصر٠ز٠٠ا Ù٠بÙتصر٠٠بÙÙر ÙÙس٠٠ش ÙÙÙÙع اخÙ٠شخص ÙØبÙ٠ا٠Ùع٠٠اÙÙ٠بØب٠٠ÙÙ Ù Ø´ عاÙز..Ùا٠Ù٠اÙاخر د٠ÙÙأذ٠٠شاعر٠اÙا..٠اÙشخص ÙÙ Ù Ø´ Ù Ùرر ÙتغÙر ا٠Ùع٠٠اÙÙÙ ÙÙرØÙ٠أÙا اÙÙÙ Ùزع٠٠Ùتضغط.</p>
<p> ;</p>
<h2>اÙØÙÙÙØ© إ٠تطبÙÙ ÙظرÙØ© &#8220;Let Them&#8221; Ù Ø´ سÙÙØ ÙÙÙ٠٠رÙØ ÙÙÙبÙ.</h2>
<p>داÙ٠ا٠بÙÙر ÙÙس٠أÙب٠اÙÙاس ز٠٠ا Ù٠ا بد٠٠ا Ø£ØاÙ٠أغÙرÙÙ Ùد٠خÙاÙ٠أتØرر Ù Ù ØÙ Ù Ø«ÙÙÙØ Ùبدأت أشÙ٠اÙØÙاة ب٠ÙظÙر جدÙد. Ù ÙÙØ´ Øاجة Ø£Øس٠٠٠إÙ٠تÙاÙ٠اÙسÙا٠جÙا ÙÙسÙØ Ùتدر٠إ٠ÙÙت٠اÙØÙÙÙÙØ© Ù٠اختÙار ردÙد Ø£ÙعاÙÙØ Ù Ø´ Ù٠اÙتØÙÙ ÙÙ ØÙاة اÙآخرÙÙ.</p>
<p>Ø£Ùا Ùس٠بتعÙÙ Ø ÙÙس٠بغÙØ·Ø ÙÙÙ ÙØ£Ù٠٠رة ÙÙ ØÙات٠بØس Ø¥ÙÙ Ø®ÙÙÙØ©… Ù Ø´ ٠جبرة أثبت Øاجة ÙØØ¯Ø Ù Ø´ ٠جبÙرة أعÙØ´ عÙ٠تÙÙعات اÙÙاس. بعÙØ´ ÙØظات٠بØÙÙÙتÙØ§Ø Ùأد٠ÙÙس٠ÙÙÙÙ ØÙاÙÙا اÙ٠ساØØ© ÙÙÙ٠ز٠٠ا Ø¥ØÙا. ÙÙ٠دÙØ ÙÙÙت ÙÙع ٠٠اÙØرÙØ© ٠اÙÙتش ÙاÙرة Ø¥ÙÙا Ù ÙجÙدة.<br />
ÙÙÙ ÙÙت بتدÙر عÙ٠طرÙÙØ© ترÙØ ÙÙب٠ÙتخÙ٠عÙÙØ Ø¬Ø±Ø¨ Ø¥Ù٠تسÙب اÙØ£Ù Ùر ت٠ش٠بطبÙعتÙا… ÙسÙبÙÙ . Ø£ÙÙات ÙتÙØ±Ø Ø¯Ù Ø¨ÙÙÙ٠أÙبر ÙدÙØ© Ù Ù Ù٠تÙد٠Ùا ÙÙÙسÙ.</p>
<p> ;</p>

الفوضى الخلاقة: معارك عربية بين الإنهيار والصمود
<p>بÙÙÙ : بÙجت اÙعبÙدÙ</p>
<p>Ù٠ظ٠عاÙÙ ÙÙ Ùج باÙأز٠ات ÙاÙتØÙÙات اÙسÙاسÙØ©Ø Ø·ÙرØت ÙظرÙØ© اÙÙÙض٠اÙØ®ÙاÙØ© Ùأداة استراتÙجÙØ© استخد٠تÙا اÙÙÙ٠اÙÙبر٠Ùإعادة صÙاغة اÙÙ ÙØ·ÙØ© اÙعربÙØ© ÙÙ٠٠صاÙØÙا اÙخاصة. Ùرغ٠اÙجد٠اÙذ٠أثارتÙØ Ùإ٠آثارÙا اÙ٠باشرة ÙاÙت ÙاضØØ© Ù٠عدد ٠٠اÙدÙ٠اÙعربÙØ© اÙت٠عصÙت بÙا رÙØ§Ø Ùذ٠اÙÙظرÙØ©Ø ÙاÙت٠Ù٠تÙ٠٠جرد Ø£ÙÙار ÙظرÙØ© ب٠تطبÙÙات ع٠ÙÙØ© ÙدÙت Ø¥Ù٠تÙÙÙ٠اÙ٠جت٠عات Ùإعادة تشÙÙÙÙا ÙÙÙ ÙÙاÙب جدÙدة.</p>
<h3><a href="https://alshamsnews.com/2024/11/29/%d8%a8%d9%84%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a7%d9%81%d8%af%d9%8a%d9%86/">بÙاد اÙراÙدÙ٠بÙا رÙاÙد.. ÙاÙÙ “Gap” اÙترÙ٠اÙسبب</a></h3>
<p>ترجع جذÙر ٠صطÙØ Ø§ÙÙÙض٠اÙØ®ÙاÙØ© Ø¥Ù٠اÙÙÙÙسÙ٠اÙÙÙÙد٠برÙارد ÙÙÙØ³Ø Ø§Ùذ٠رأ٠Ù٠اÙÙÙض٠ÙسÙÙØ© Ùإعادة بÙاء اÙ٠جت٠عات ب٠ا Ùخد٠اÙ٠صاÙØ Ø§ÙÙبر٠ÙÙÙÙ٠اÙعاÙÙ ÙØ©. ÙÙد٠ت Ùذ٠اÙÙظرÙØ© ÙÙسÙا ÙØاÙØ© ٠٠اÙاضطراب اÙ٠تع٠د اÙØ°Ù ÙÙØدث تغÙÙرات جذرÙØ© Ù٠بÙÙØ© اÙ٠جت٠عات. ÙباÙÙسبة ÙÙشر٠اÙØ£ÙØ³Ø·Ø Ùا٠اÙÙد٠اÙ٠عÙÙ Ù Ù Ùذ٠اÙÙÙض٠Ùشر اÙدÙÙ ÙراطÙØ© ÙÙسÙÙØ© ÙÙ ÙاجÙØ© “اÙتطر٠اÙدÙÙÙ”Ø Ø¥Ùا أ٠اÙتطبÙ٠اÙع٠ÙÙ ÙÙÙظرÙØ© أد٠إÙ٠اÙÙÙار دÙÙ ÙاÙدÙاع صراعات د٠ÙÙØ© ترÙت شعÙب اÙÙ ÙØ·ÙØ© ÙÙ ØاÙØ© ٠٠اÙت٠زÙ.</p>
<h3>اÙÙÙض٠اÙØ®ÙاÙØ© Ù٠اÙدÙ٠اÙعربÙØ©</h3>
<p>ÙاÙت ÙÙبÙا Ø£Øد أبرز Ù Ø³Ø§Ø±Ø Ø§ÙÙÙض٠اÙØ®ÙاÙØ©Ø ØÙØ« أد٠اÙتدخ٠اÙدÙÙÙ ÙÙإطاØØ© بÙظا٠٠ع٠ر اÙÙذاÙ٠إÙ٠اÙÙÙار اÙدÙÙØ©. Ù٠ع غÙاب ٠ؤسسات ÙÙÙØ© تØ٠٠اÙبÙÙØ© اÙاجت٠اعÙØ© ÙاÙسÙاسÙØ©Ø ØªØÙÙت اÙبÙاد Ø¥Ù٠ساØØ© صراع بÙ٠اÙÙ ÙÙÙØ´Ùات اÙ٠سÙØØ©Ø ÙأصبØت ٠سرØÙا ÙتدخÙات Ø¥ÙÙÙÙ ÙØ© ÙدÙÙÙØ©.</p>
<p>ÙÙ ÙÙ٠اÙعرا٠بعÙدÙا ع٠تطبÙÙ Ùذ٠اÙÙظرÙØ©. Ùبعد اÙإطاØØ© بÙظا٠صدا٠ØسÙÙ Ù٠عا٠2003Ø ØªÙÙÙت ٠ؤسسات اÙدÙÙØ©Ø Ùسادت ØاÙØ© ٠٠اÙÙÙضÙ. اتسعت اÙصراعات اÙطائÙÙØ©Ø ÙØ£ØµØ¨Ø Ø§Ùعرا٠ÙÙ ÙذجÙا ٠أساÙÙÙا ÙÙÙدا٠اÙØ£Ù Ù ÙاÙاستÙØ±Ø§Ø±Ø ØÙØ« ÙØ´Ùت ÙÙ Ù ØاÙÙات إعادة اÙبÙاء Ù٠ظ٠اÙتجاذبات اÙØ¥ÙÙÙÙ ÙØ© ÙاÙصراعات اÙداخÙÙØ©.</p>
<p>ÙØ´Ùد اÙÙ٠٠أÙضÙا Ù Ùجة عار٠ة ٠٠اÙØ§Ø¶Ø·Ø±Ø§Ø¨Ø§ØªØ ØÙØ« استغÙت ÙظرÙØ© اÙÙÙض٠اÙØ®ÙاÙØ© اÙØ®ÙاÙات اÙداخÙÙØ© ÙتØÙÙ٠اÙبÙاد Ø¥Ù٠ساØØ© Øرب ٠تعددة اÙأطراÙ. اÙÙÙار اÙدÙÙØ© اÙ٠رÙزÙØ©Ø ØªØµØ§Ø¹Ø¯ اÙصراعات اÙÙبÙÙØ© ÙاÙطائÙÙØ©Ø ÙتØÙ٠اÙÙ٠٠إÙ٠أز٠ة Ø¥ÙساÙÙØ© Ù Ø³ØªÙ Ø±Ø©Ø ÙاÙت ÙÙÙا Ùتائج ٠باشرة ÙÙذ٠اÙسÙاسة.</p>
<p>أ٠ا Ù٠اÙسÙداÙØ ÙÙد أظÙرت اÙØ£Øداث اÙأخÙرة ÙÙÙ ÙÙ ÙÙ ÙÙÙÙض٠اÙسÙاسÙØ© أ٠تتطÙر Ø¥Ù٠صراعات د٠ÙÙØ©. Ùبعد عÙÙد ٠٠اÙاÙÙسا٠ÙاÙØ§Ø¶Ø·Ø±Ø§Ø¨Ø§ØªØ Ø¯Ø®Ù Ø§ÙسÙدا٠ÙÙ ØÙÙØ© Ù Ùرغة ٠٠اÙÙØ²Ø§Ø¹Ø§ØªØ ØÙØ« ساÙ٠غÙاب اÙرؤÙØ© اÙسÙاسÙØ© اÙÙ ÙØدة Ùضع٠اÙ٠ؤسسات اÙÙØ·ÙÙØ© Ù٠تØÙÙÙ٠إÙÙ ÙÙ Ùذج آخر ÙÙÙÙض٠اÙØ®ÙاÙØ©.</p>
<p>ÙÙÙد ÙصÙت اÙÙÙض٠اÙØ®ÙاÙØ© Ø¥Ù٠ذرÙتÙا Ù٠سÙرÙØ§Ø ØÙØ« تØÙÙت اÙتÙاضة شعبÙØ© Ø¥ÙÙ Øرب شا٠ÙØ© تعددت أطراÙÙا. اÙتدخÙات اÙدÙÙÙØ©Ø ÙاÙÙسا٠اÙÙ Ø¹Ø§Ø±Ø¶Ø©Ø Ùصراع اÙ٠صاÙØ Ø§ÙØ¥ÙÙÙÙ ÙØ©Ø ÙÙ Ø°Ù٠ساÙÙ Ù٠تØÙÙ٠اÙبÙاد Ø¥Ù٠ساØØ© Øرب ÙارثÙØ©. Ù٠ع تد٠Ùر اÙ٠دÙØ ÙتشرÙد اÙÙ ÙاÙÙÙØ ÙتØÙ٠سÙرÙا Ø¥ÙÙ Ù Ùعب ÙÙÙ٠إÙÙÙÙ ÙØ© ÙدÙÙÙØ©Ø Ø£ØµØ¨Øت اÙبÙاد Ø´Ùادة ØÙØ© عÙ٠اÙÙÙÙØ© اÙباÙظة ÙÙÙÙض٠اÙØ®ÙاÙØ©.</p>
<h3>اÙتجربة اÙ٠صرÙØ©</h3>
<p>Ùسط Ùذا اÙÙ Ø´Ùد اÙÙ Ø¶Ø·Ø±Ø¨Ø Ø¨Ø±Ø²Øª اÙتجربة اÙ٠صرÙØ© ÙØاÙØ© ٠غاÙرة أثبتت أ٠اÙÙع٠اÙشعب٠ÙاÙتØا٠٠ؤسسات اÙدÙÙØ© ÙÙ Ù٠أ٠ÙÙÙÙا ØصÙÙا Ù ÙÙعÙا أ٠ا٠٠خططات اÙÙÙضÙ. Ù٠ع اÙدÙاع Ø«Ùرة 30 ÙÙÙÙÙ 2013Ø Ùعب اÙجÙØ´ اÙ٠صر٠دÙرÙا Ù ØÙرÙÙا Ù٠اÙØÙاظ عÙ٠اÙدÙÙØ© ÙÙ ÙعÙا ٠٠اÙاÙزÙا٠ÙØ٠اÙÙÙضÙ. ÙÙÙ ÙÙ٠اÙجÙØ´ ÙØد٠اÙعا٠٠اÙØØ§Ø³Ù Ø Ø¨Ù Ùا٠اÙÙ Ø«ÙÙÙÙ ÙاÙÙ ÙÙرÙ٠اÙ٠صرÙÙÙ ÙÙ Ø·ÙÙعة اÙÙ ÙاجÙØ© اÙÙÙرÙØ©Ø ØÙØ« ساÙÙ Ùا Ù٠تÙعÙØ© اÙشعب ب٠خاطر اÙÙÙار اÙدÙÙØ©.</p>
<p>ÙÙد Ùد٠ت ٠صر ÙÙ ÙذجÙا ٠تÙا٠ÙÙا ÙÙ Ù ÙاجÙØ© اÙÙÙض٠اÙØ®ÙاÙØ©Ø ØÙØ« تعاÙÙت اÙÙÙادة اÙسÙاسÙØ© ٠ع اÙجÙØ´ Ù٠ؤسسات اÙدÙÙØ© ÙØ٠اÙØ© اÙبÙاد ٠٠اÙاÙÙÙار. Ùذا اÙتØاÙ٠بÙ٠اÙشعب ÙاÙ٠ؤسسات اÙÙØ·ÙÙØ© أثبت أ٠اÙÙÙÙ٠صÙÙا ÙاØدÙا أ٠ا٠٠ØاÙÙات زعزعة اÙاستÙرار ÙÙÙ٠بإÙشا٠أ٠٠خططات تÙد٠إÙÙ Ùشر اÙÙÙضÙ.</p>
<p>ÙÙإجÙاض ٠خططات اÙÙÙض٠اÙØ®ÙاÙØ© ÙØ°ÙØ Ùجب أ٠تدر٠اÙشعÙب ÙاÙدÙ٠اÙعربÙØ© أ٠اÙÙÙاÙØ© Ø®Ùر ٠٠اÙعÙØ§Ø¬Ø Ùأ٠بÙاء اÙØصاÙØ© اÙÙØ·ÙÙØ© ÙتطÙب رؤÙØ© شا٠ÙØ© تعت٠د عÙ٠عدة رÙائز. Ø£ÙÙÙØ§Ø Ùجب تعزÙز اÙ٠ؤسسات اÙÙØ·ÙÙØ© ÙتÙÙÙ Ùادرة عÙÙ Ù ÙاجÙØ© اÙØ£Ø²Ù Ø§ØªØ Ø¹Ø¨Ø± تطÙÙر اÙبÙÙØ© اÙإدارÙØ© ÙاÙØ£Ù ÙÙØ© ÙÙدÙÙØ© ÙإبعادÙا ع٠اÙاستÙطابات اÙسÙاسÙØ© أ٠اÙØ£ÙدÙÙÙÙجÙØ©. ثاÙÙÙØ§Ø Ùجب ترسÙØ® Ø«ÙاÙØ© اÙØÙار ÙاÙاعتدا٠داخ٠اÙÙ Ø¬ØªÙ Ø¹Ø§ØªØ ÙاÙتأÙÙد عÙÙ ÙÙ٠اÙÙ ÙاطÙØ© اÙت٠تض٠٠أ٠تÙÙ٠اÙÙÙاءات ÙÙÙØ·Ù ÙÙÙس ÙÙØ·Ùائ٠أ٠اÙج٠اعات.</p>
<p>ثاÙØ«ÙØ§Ø ÙÙعب اÙتعÙÙ٠دÙرÙا رئÙسÙÙا Ù٠بÙاء Ùع٠اÙأجÙا٠اÙجدÙØ¯Ø©Ø Ùذا Ùجب اÙترÙÙز عÙ٠تطÙÙر اÙÙ ÙاÙج اÙت٠تغرس ÙÙ٠اÙتÙÙÙر اÙÙÙد٠ÙاÙÙØدة اÙÙØ·ÙÙØ©. رابعÙØ§Ø Ùا بد Ù Ù ÙجÙد إعÙا٠Ùاع٠ÙÙÙÙ ÙادرÙا عÙÙ Ùش٠اÙ٠ؤا٠رات ÙتÙدÙ٠خطاب ÙرÙع اÙÙع٠اÙعا٠ب٠خاطر اÙاÙزÙا٠إÙ٠اÙÙÙضÙ. Ù٠ا أ٠اÙتعاÙ٠اÙØ¥ÙÙÙ٠٠بÙ٠اÙدÙ٠اÙعربÙØ© Ùعد ضرÙرÙÙا ÙتشÙÙ٠جبÙØ© Ù ÙØدة ضد اÙتدخÙات اÙخارجÙØ© اÙت٠تستغ٠ÙÙاط اÙضعÙ. ÙأخÙرÙØ§Ø Ùإ٠اÙاستث٠ار Ù٠اÙشباب باعتبارÙ٠طاÙØ© اÙ٠ستÙبÙØ Ø¹Ø¨Ø± تÙÙÙر Ùرص اÙع٠٠ÙتشجÙعÙ٠عÙ٠اÙ٠شارÙØ© اÙسÙاسÙØ©Ø Ù٠اÙض٠اÙØ© اÙØÙÙÙÙØ© ÙØ٠اÙØ© اÙ٠جت٠عات ٠٠أ٠٠ØاÙÙØ© Ùزعزعة استÙرارÙا.</p>
<p>إذا ت٠ÙÙت اÙشعÙب ÙاÙدÙ٠اÙعربÙØ© ٠٠اÙع٠٠ÙÙÙ Ùذ٠اÙرÙØ§Ø¦Ø²Ø ÙØ¥ÙÙا Ù٠تÙتÙ٠بإÙشا٠خطط اÙÙÙض٠اÙØ®ÙاÙØ© ÙØØ³Ø¨Ø Ø¨Ù Ø³ØªÙØªØ Ø£Ø¨ÙابÙا جدÙدة ÙبÙاء ٠ستÙب٠٠ستÙر Ù٠زدÙر ÙÙأجÙا٠اÙÙاد٠ة.</p>

إزاي بتصنع مشاكلك بإيديك؟ الحقيقة الصادمة لقانون الانعكاس!
<p><strong>سارة ٠جدÙ</strong></p>
<p>Ù٠عÙ٠اÙÙÙØ³Ø ÙاÙÙ٠اÙاÙعÙاس بÙÙÙ٠إ٠اÙØ¥Ùسا٠ز٠اÙ٠راÙØ©Ø ØÙات٠بتعÙس Ø£ÙÙار٠Ù٠شاعر٠ÙØ£ÙعاÙÙ. ب٠عÙ٠إ٠اÙÙ٠بتØس بÙ٠أ٠بتÙÙر ÙÙÙØ Ø¨Ùترج٠ÙطرÙÙØ© تصرÙÙØ ÙاÙÙ٠بدÙر٠بÙجذب ÙÙس اÙطاÙØ© ٠٠اÙعاÙ٠اÙÙÙ ØÙاÙÙÙ. ÙÙ ÙÙت Ù ÙÙا٠سÙبÙØ© ÙØºØ¶Ø¨Ø ÙتÙاÙ٠إ٠اÙÙ ÙاÙÙ ÙاÙأشخاص اÙÙ٠بتÙابÙÙ٠غاÙبÙا بÙعÙسÙا اÙ٠شاعر دÙ. ÙÙÙ ÙÙت Ù ÙÙا٠إÙجابÙØ© ÙتÙبÙØ ÙتÙاÙ٠إ٠ØÙات٠ÙتتغÙر ÙÙØ£ØسÙ..<br />
ÙÙ ÙتÙر Ù Ø´ بÙصدÙÙا Ù٠عÙ٠اÙÙÙس Ø£Ù ÙÙاÙÙÙÙØ§Ø ÙÙا Ø£Ùا ÙÙت بصد٠أÙا جربت اصد٠عÙ٠سبÙ٠اÙتجربة ٠اÙÙضÙÙ..ÙÙت ÙÙÙس٠٠ش جاÙز ØÙات٠تتغÙØ±Ø Ùخسر اÙÙ Ø Ù Ø£ØºÙÙØ© اÙÙÙا٠٠ØÙ Ùد اÙعسÙÙÙ Ù٠اÙØ®ÙÙÙØ© &#8220;٠ا ÙÙ Ùد٠Ùد٠باÙظة&#8221; Ù ÙÙت اجرب ..<br />
جاÙÙ ÙÙت ÙÙ ØÙات٠٠Ùا٠جÙاÙا غضب ٠خذÙا٠٠٠أشخاص Ù Ù ÙاÙ٠٠شغ٠٠ش ٠تÙدرة ÙÙÙ..Ù ÙضÙت Ù ÙاÙÙØ ÙÙÙ Øاجة Ù Ø´ ØباÙا Ù ÙجÙدة Ù ÙÙØ´ Ùدا٠٠Ø٠اÙا اÙا اجرب..</p>
<h3>تعاÙÙا Ùعر٠ØدÙتة ÙÙر اÙØ£ÙÙ!</h3>
<p>ÙÙ ÙÙ٠٠٠اÙØ£ÙØ§Ù Ø ÙÙر Ùا٠ÙاÙ٠عÙ٠شاطئ اÙبØر ÙÙت اÙغرÙب. اÙÙ Ùج Ùا٠بÙØ·Ùع ÙÙÙز٠Ùدا٠ÙØ ÙاÙسÙÙÙ ØÙاÙÙ٠اÙÙ Ùا٠Ùا٠بÙØسس٠بغربة غرÙبة. ÙÙر Ùا٠بÙ٠ر بÙترة صعبة ÙÙ ØÙاتÙØ Ù ÙÙاÙØ© Ø¥Øباط ÙتÙتر. ÙÙ Øاجة ØÙاÙÙÙ ÙاÙت بتضغط عÙÙÙØ Ø´ØºÙÙ Ù Ø´ ٠ستÙØ±Ø Ø¹ÙاÙات٠٠ع أصØاب٠ÙØ£ÙÙ٠٠تÙØªØ±Ø©Ø ÙØت٠صØت٠اÙÙÙسÙØ© Ù Ø´ Ù٠أØس٠ØاÙاتÙا.<br />
ÙÙÙ Ùدا٠اÙبØر ÙÙا٠بصÙت Ùاط٠ÙØ£Ù٠بÙÙÙÙ ÙÙسÙ:</p>
<p>&#8220;ÙÙÙ ÙÙ Øاجة ضدÙØ ÙÙ٠اÙدÙÙا Ù Ø´ ٠اشÙØ© ز٠٠ا Ø£Ùا عاÙزØ&#8221;</p>
<p>Ù٠اÙÙØظة دÙØ Ø´Ø§Ù Ø±Ø§Ø¬Ù ÙبÙر Ù٠اÙسÙØ Ùاعد ÙرÙب Ù ÙÙØ Ø¨Ø§ØµØµ ÙÙÙ ÙØ© ÙÙØ£Ù٠بÙÙÙر ÙÙ Øاجة ع٠ÙÙØ©. اÙراج٠ÙاØظ Ùظرات ÙÙر اÙØ«ÙÙÙØ© ÙÙا٠Ù٠بابتسا٠ة ÙادÙØ©:</p>
<p>&#8220;شاÙ٠اÙبØر دÙØ&#8221;<br />
ÙÙر استغرب اÙسؤا٠Ùرد بØذر:</p>
<p>&#8220;Ø£ÙÙØ©Ø Ø´Ø§ÙÙÙ&#8230; ÙÙÙØ&#8221;<br />
اÙراج٠أشار بإÙد٠عÙ٠اÙÙ Ùج ÙÙاÙ:</p>
<p>&#8220;اÙÙ Ùج د٠بÙعÙس ÙÙ Øاجة بتØص٠ØÙاÙÙÙ. Ù٠ر٠Ùت Øص٠Ù٠اÙÙ ÙØ©Ø Ùتع٠٠دÙائر ترجع ÙÙ. ÙÙÙ ØØ·Ùت Ø¥Ùد٠بÙدÙØ¡Ø Ø§ÙÙ ÙØ© تبÙÙ ÙادÙØ©. ØÙاتÙا ز٠اÙÙ ÙØ© دÙ. اÙÙ٠بتبعث٠ÙÙعاÙÙ Ø Ø¨Ùرجع ÙÙ.&#8221;<br />
ÙÙر بص ÙÙÙ ÙØ©Ø ÙÙÙ٠٠ا ÙÙÙ Ø´ اÙÙÙرة بشÙÙ Ùا٠Ù. سأ٠اÙراجÙ:</p>
<p>&#8220;تÙصد Ø¥ÙÙØ ÙعÙ٠أÙا اÙسبب Ù٠اÙÙ٠بÙØص٠ÙÙØ&#8221;<br />
اÙراج٠ابتس٠ÙÙاÙ:</p>
<p>&#8220;Ù Ø´ بتÙÙ٠اÙظرÙÙ ÙÙا اÙÙØ§Ø³Ø ÙÙ Øاجة بÙØس بÙÙا أ٠بÙع٠ÙÙا بتÙعÙس عÙÙÙا. ÙÙ ÙÙرت Ù٠اÙÙÙ ÙاÙص٠طÙ٠اÙÙÙØªØ ÙتÙض٠Øاسس باÙÙÙص. ÙÙ Ø´Ùت ÙÙ Øاجة سÙبÙØ©Ø ÙتÙاÙ٠اÙدÙÙا ÙÙÙا سÙدا. ÙÙÙ Ù٠بدأت تغÙر جÙاÙØ ÙتÙاÙ٠اÙÙÙ ØÙاÙÙ٠بÙتغÙر.&#8221;<br />
ÙÙر Ùض٠ساÙت Ø´ÙÙØ©Ø Ùا٠ÙÙا٠اÙراج٠بÙØر٠Øاجة جÙاÙ. سأÙ:</p>
<p>&#8220;طب ÙعÙ٠أع٠٠إÙÙØ Ø£ØºÙر إزاÙØ&#8221;<br />
اÙراج٠Ùا٠Ùأخد خطÙØ© ÙاØÙØ© اÙبØØ±Ø ÙÙÙر تبعÙ. اÙراج٠ÙاÙ:</p>
<p>&#8220;جرب تبدأ بØاجة بسÙطة. ز٠اÙبØر دÙØ ØاÙ٠تÙÙÙ ÙادÙ. ÙÙ Øد زعÙÙØ Ø¨Ø¯Ù Ù Ø§ ترد بÙÙس اÙسÙبÙØ©Ø Ø±Ø¯ Ø¨Ø§Ø¨ØªØ³Ø§Ù Ø©Ø Ø³Ø§Ù Ø Ø§Ù Ù ØªØ³Ø§Ù ØØ´ ٠تردش ØتÙ.<br />
ÙÙ ØسÙت اÙ٠٠ضاÙÙØ ÙÙر ÙÙ Øاجة ÙاØدة ØÙÙØ© ØصÙت Ù٠ا٠Ùدا٠عÙÙÙ ÙÙ Øاجة ØÙÙØ© اÙت اصÙا٠٠ش شاÙÙÙا. اÙتغÙÙر Ù Ø´ بÙØص٠ÙÙ ÙÙÙ ÙÙÙÙØ©Ø ÙÙÙÙ Ùبدأ بخطÙØ© ÙاØدة Øت٠Ù٠صغÙرة.&#8221;<br />
ÙÙر بدأ ÙÙÙر ÙÙ ÙÙا٠اÙراجÙØ ÙÙ٠راجع بÙت٠Ùرر Ùجرب. ٠٠اÙÙÙ٠دÙØ Ø¨Ø¯Ø£ ÙغÙر اÙطرÙÙØ© اÙÙ٠بÙØ´Ù٠بÙÙا ÙÙس٠ÙاÙدÙÙا. Ù٠ا Ùا٠ÙÙاج٠٠شÙÙØ©Ø Ø¨Ø¯Ù Ù Ø§ Ùغر٠Ù٠اÙسÙبÙØ©Ø Ùا٠بÙÙÙر: &#8220;Ø¥Ù٠اÙÙÙ Ù Ù Ù٠أع٠Ù٠عشا٠أغÙر اÙÙضع..أ٠اغÙر اÙÙÙ Øاس٠ازاÙØ&#8221;<br />
٠ع اÙÙÙØªØ ÙÙر ÙاØظ Ø¥Ù ØÙات٠بتتØسÙ. عÙاÙات٠بÙت اØسÙØ Ø´ØºÙ٠بÙ٠٠ستÙر Ø£ÙØªØ±Ø ÙØت٠ÙÙ ÙÙس٠بÙ٠٠رتاØ. ÙÙر ÙÙ٠إ٠اÙبØر Ùا٠بÙعÙ٠٠درس بسÙØ·:<br />
اÙدÙÙا بتعÙس اÙÙ٠جÙاÙØ Ø²Ù Ø§ÙÙ ÙØ© اÙÙ٠بتعÙس اÙس٠ا. ÙÙ ØØ·Ùت جÙا٠ÙÙØ±Ø Ø§ÙدÙÙا ÙÙÙا ÙتÙÙر ٠عاÙ.</p>
<p>ÙاÙÙ٠اÙاÙعÙاس باختصار بÙÙÙ٠إ٠ØÙاتÙا Ù٠شاعرÙا ÙØ£ÙÙارÙا بتعÙس اÙÙ٠جÙاÙا. ÙعÙÙØ Ø§ÙÙ٠بÙØ´ÙÙÙ Ù٠اÙÙاس Ø£Ù Ù٠اÙÙ ÙاÙÙ ØÙاÙÙÙØ ØºØ§ÙبÙا بÙÙÙ٠اÙعÙاس ÙØاجة ÙÙ٠أÙØªØ Ø³Ùاء Øاجة Ø¥ÙجابÙØ© أ٠سÙبÙØ©.</p>
<p> ;</p>
<p><strong>إزا٠د٠بÙأثر عÙÙÙاØ</strong></p>
<p>1. ٠شاعر٠Ù٠اÙ٠راÙØ©<br />
ÙÙ Øد بÙزعÙ٠أ٠بÙضاÙÙÙØ Ø¬Ø±Ø¨ تسأ٠ÙÙسÙ: &#8220;Ù٠اÙÙ٠بÙع٠Ù٠بÙعÙس Øاجة Ø£Ùا Ù Ø´ عاجباÙÙ ÙÙ ÙÙسÙØ&#8221; Ù Ø«ÙÙØ§Ø Ù٠اÙت بتشÙÙ Øد Ø£ÙاÙÙ ÙبتضاÙÙ Ù Ù٠جدÙØ§Ø Ù Ù Ù٠تÙÙ٠د٠صÙØ© عÙد٠بتØاÙ٠تÙرب Ù ÙÙا أ٠تتجاÙÙÙØ§Ø ÙÙ Øد بÙع٠٠Øاجة بتضاÙÙ٠اÙتر ٠٠٠رة Ø Ù٠اÙÙ ÙÙ٠د٠اتÙرر ٠عا٠Ùب٠ÙØ¯Ù Ø Ø§Ø³Ø£Ù ÙÙس٠اÙ٠اÙÙÙ ÙÙت Ù Øتاج٠ز٠ا٠ÙÙ ØصÙØ´ ٠اتضاÙÙت اÙ٠عشا٠غاÙبا٠اÙت ٠شاعر٠Ùس٠٠خزÙÙا تجا٠اÙÙ ÙÙ٠د٠باÙتØدÙد..خد ٠سؤÙÙÙØ© اÙ٠تغÙر اØساس٠اÙÙ٠جÙÙ Ùب٠٠ا تØاÙ٠تغÙر اÙشخص اÙÙ٠بÙضاÙÙÙ..</p>
<p>2. اÙعÙاÙات اÙعÙاس ÙÙذات<br />
اÙعÙاÙات اÙÙ٠بتدخÙÙا بتعÙس ØاÙت٠اÙداخÙÙØ©. ÙÙ ÙÙت ÙÙ ØاÙØ© رضا ÙسÙا٠داخÙÙØ ÙتÙاÙÙ ÙÙس٠بتÙجذب ÙÙاس بÙÙدرÙا دÙ. ÙÙÙ ÙÙت Ù٠صراع Ø£Ù ØºØ¶Ø¨Ø Ù Ù Ù٠تÙاÙÙ ÙÙس٠بتجذب Ùاس بتعÙس ÙÙس اÙ٠شاعر.<br />
Ù٠ا تدر٠إ٠اÙÙ ÙاÙ٠اÙÙ٠بتØص٠ØÙاÙÙÙ Ù٠٠راÙØ© ÙÙÙØ ÙتبÙ٠عÙد٠Ùرصة ÙبÙرة Ø¥Ù٠تطÙر ÙÙسÙ. ÙÙ Ù ÙÙ٠بÙزعÙÙا أ٠بÙÙرØÙا Ù٠رساÙØ© ÙÙÙا ع٠Øاجة جÙاÙا Ù Øتاجة شغ٠أ٠اØتÙاÙ.</p>
<p>تخÙ٠إÙ٠٠اش٠Ù٠اÙشارع ÙØ´Ùت Øد ٠تÙتر ÙعصبÙØ ÙØسÙت Ø¥Ù٠٠ضاÙÙ Ù ÙÙ. Ù Ù Ù٠د٠ÙÙÙ٠اÙعÙاس Ø¥Ù٠أÙت Ù٠ا٠عصب٠ÙÙ Ø´ Ùاخد باÙÙØ Ø£Ù ÙÙ ÙÙ Ù Øتاج تتعÙ٠تتعا٠٠٠ع تÙتر اÙÙاس بÙدÙØ¡.<br />
<strong>اÙØ®Ùاصة</strong>:<br />
ÙاÙÙ٠اÙاÙعÙاس بÙØ®ÙÙÙا Ùبص ÙÙÙ ÙاÙÙ ÙاÙÙاس ÙÙرصة ÙÙÙÙ ÙÙسÙا Ø£Ùتر. بد٠٠ا ÙØÙ٠أ٠Ùزع٠٠٠غÙرÙØ§Ø ÙÙÙر:<br />
&#8220;Ø¥Ù٠اÙرساÙØ© اÙÙ٠اÙØÙاة عاÙزة تÙصÙÙاÙ٠٠٠اÙÙ ÙÙ٠دÙØ&#8221;</p>

بين الحب والزواج..ما علاقة الجزمة بـ الاكس
<p><strong>بÙÙÙ / سارة ٠جدÙ</strong></p>
<p>Ù٠عÙد٠جز٠ة ضÙÙØ© Ù Ø´ عÙÙ Ù ÙاسÙØ Ùترجع تÙبسÙØ§Ø Ø·Ùب ÙÙ Ùررت تÙبسÙØ§Ø Ùسعت ٠ع اÙÙÙØªØ ØºØ§ÙبÙا Ùا<br />
ÙÙ Ù٠ا ØاÙÙت تÙبسÙØ§Ø Ø§Ùجز٠ة ÙتÙض٠تعÙر٠ÙتضاÙÙÙ.<br />
Ø·Ùب Ø¥Ù٠اÙÙÙ ÙØ®ÙÙ٠تØتÙظ بجز٠ة ضÙÙØ©Ø Ù٠٠تخÙÙ٠إÙÙ Ù Ø´ ÙتÙاÙ٠جز٠ة تاÙÙØ© Ù ÙاسÙØ ÙÙا Ù ÙتÙع Ø¥ÙÙا Ø£ØÙ٠جز٠ة Ù Ù Ù٠تÙاÙÙÙØ§Ø Ø±ØºÙ Ø¥ÙÙا Ùاجعة رجÙÙØ<br />
ÙØ£Ùا ÙÙا Ù Ø´ بتÙÙ٠ع٠اÙجز٠ة.<br />
ÙÙ Ùاس بÙت٠سÙÙا بعÙاÙاتÙ٠اÙÙدÙÙ Ø©Ø Ø®ØµÙصÙا ٠ع شرÙاء سابÙÙÙ. ز٠٠ا بتØتÙظ بجز٠ة Ù Ø´ Ù Ùاس٠ÙÙ Ø´ ٠رÙØØ©Ø ÙÙÙ Ùاس بتØتÙظ بÙ&#8221;Ø¥ÙساتÙÙ &#8221; ÙÙ ØÙاتÙÙ . ÙاÙÙتÙØ¬Ø©Ø Ø£Ø°ÙØ© ٠ست٠رة ÙÙÙÙ ÙÙÙشخص اÙتاÙÙ.<br />
اÙÙ٠بÙت٠سÙÙا بعÙاÙات ÙدÙÙ Ø© اÙتÙØªØ Ø±ØºÙ Ø¥ÙÙا سببت Ùجع أ٠أÙÙ . بد٠٠ا ÙسÙبÙا ÙÙÙÙ Ù ØÙاتÙØ§Ø Ø¨Ùرجع ÙÙÙس اÙدائرة ÙÙÙرر ÙÙس اÙأخطاء.<br />
ÙÙÙØ Ù٠عشا٠اÙØ°ÙرÙات اÙØÙÙØ©Ø ÙÙا Ø®ÙÙÙا ٠٠اÙÙØدةØ<br />
Ø£ÙÙات بÙÙÙع ÙÙسÙا Ø¥ÙÙا &#8220;ÙÙبÙ٠صØاب&#8221; ٠ع اÙشرÙ٠اÙÙدÙÙ Ø Ø¨Ø³ Ù٠د٠ØÙÙÙÙØ<br />
ÙÙ Ù Ù Ù٠تÙس٠Ù٠اÙØ°ÙرÙØ§ØªØ Ø§ÙØÙÙØ© ÙاÙ٠ؤÙÙ Ø©Ø Ùتتعا٠٠طبÙعÙØ<br />
اÙعÙاÙØ© اÙÙ٠سببت Ùجع Ùب٠ÙدÙØ ØºØ§ÙبÙا Ù Ø´ ÙتتغÙر.. Ùصعب ٠خطÙبÙ٠أ٠Ù٠عÙاÙØ© Ù Ø´ رس٠ÙØ© Ù٠ستØÙÙ &#8220;٠تجÙزÙÙ&#8221; ٠اتطÙÙÙا ÙبÙÙا صØاب Ø¨Ø³Ø Ø§Ùا Ù٠اÙÙ٠بÙربطÙÙ (Ø£ÙÙاد) Ùاز٠ÙبÙÙا Ùد٠٠ÙØاÙظÙا عÙ٠عÙاÙتÙ٠تبÙÙ Ø·Ùبة Ùد٠عشا٠ÙÙسÙØ© اÙØ£ÙÙاد.<br />
ÙÙÙ ÙÙرت ÙÙ ÙÙرة &#8220;ÙبÙ٠صØاب بس&#8221;Ø Ø§Ø³Ø£Ù ÙÙسÙ: Ù٠د٠٠ÙØ·ÙÙØ ÙÙ ÙتÙدر تÙس٠Ù٠اÙØ°ÙرÙات اÙØÙÙØ© ÙاÙÙØشة Ùتتعا٠٠بشÙ٠طبÙعÙØ ÙÙا ٠جرد ÙجÙدÙ٠٠ع بعض ÙÙÙÙ٠ز٠اÙبÙزÙ٠جÙب اÙÙارØ</p>
<p>اÙ٠دÙÙÙ٠ا٠٠ÙÙÙعش ÙبÙÙ &#8220;صØاب&#8221; ٠ع اÙØ³Ø ÙÙÙ٠اخترت اÙجز٠ة باÙتØدÙد ÙتشبÙÙØ</p>
<p>Ù٠عرÙÙا ربÙا Ø´Ø±Ø Ø§Ø·Ø§Ø± اÙعÙاÙات ازا٠٠اÙجÙاز ÙÙÙÙÙ ÙÙÙ..تÙرÙبا٠٠ÙÙØ´ Øاجة ربÙا ٠شرØÙاش Ù٠اÙÙرأÙ..بس داÙ٠ا٠اÙÙاس بتتÙاس٠ÙÙاÙÙ٠ربÙا ٠بتختار ÙÙاÙÙ٠اÙدÙÙا ٠ع ا٠Ù٠اÙاخر Ùتعر٠ÙÙÙس ا٠ربÙا ٠سابش تÙصÙÙØ© ÙÙ ØÙات٠اÙا Ù ÙاÙ٠تع٠ÙÙا ازاÙ.. اÙا Ù Ø´ Ø´Ùخة ÙÙا جبت ÙÙا٠٠٠د٠اغ٠بس بجتÙد ÙÙرÙت تÙاسÙر Ù ÙÙÙت اÙتÙÙ Ù Ù Ù٠تÙÙ٠س٠عتÙÙ Ùب٠Ùد٠بس اÙØ£ÙÙد اÙÙ ÙتÙراÙ٠اÙ٠رة د٠ب٠عÙ٠جدÙد..</p>
<p>ز٠٠ا بÙÙبس Ù٠اÙعÙاÙات – ٠بÙÙبس اÙجز٠ة – اÙتشبÙØ© د٠أصÙا٠ربÙا Ø°Ùر٠Ù٠اÙÙرأ٠٠رتÙÙ.</p>
<h3><strong>{ÙÙÙÙÙ ÙÙبÙاس٠ÙÙÙÙÙ Ù ÙÙØ£ÙÙÙتÙÙ Ù ÙÙبÙاس٠ÙÙÙÙÙÙÙ}</strong></h3>
<p>د٠آÙØ© عظÙÙ Ø© جدÙا بتÙص٠اÙعÙاÙØ© بÙ٠اÙزÙجÙ٠بأبسط Ùأج٠٠تشبÙÙ. اÙÙباس داÙ٠ا٠ÙرÙب Ù ÙÙØ Ù Ùا٠س Ùجس٠ÙØ ÙÙ ÙÙØ´ Øد ÙÙدر Ù٠ش٠٠٠غÙرÙØ Ø²Ù Ù Ø§ Ù ÙÙØ´ زÙج ÙÙدر ÙعÙØ´ ٠٠غÙر ٠رات٠ÙÙا Ù٠تÙدر تعÙØ´ ٠٠غÙرÙ. اÙÙبس بÙستر اÙØ¬Ø³Ø¯Ø Ùد٠برض٠اÙتشبÙ٠ا٠اÙزÙجÙÙ Ùاز٠ÙسترÙا Ø¨Ø¹Ø¶Ø ÙÙغطÙا عÙ٠عÙÙب بعض ÙÙØ®ÙÙا أسرار بÙتÙ٠ع٠أ٠Øد.<br />
اÙÙباس Ù٠ا٠ر٠ز ÙÙعÙØ©Ø Ø²Ù Ù Ø§ اÙÙبس بÙØ٠٠اÙØ¬Ø³Ø¯Ø Ø§ÙزÙجÙ٠بÙØÙ Ùا بعض ٠٠اÙØØ±Ø§Ù Ø Ù٠سÙد ÙÙÙا ÙÙ٠سÙد ÙÙÙ.</p>
<p>اÙÙب٠عÙÙ٠اÙصÙاة ÙاÙسÙا٠ÙاÙ: &#8220;Ø¥Ù ÙرÙت Ù ÙÙا Ø®ÙÙا٠رضÙت Ù ÙÙا آخر&#8221;Ø ÙعÙÙ ÙÙ Ù٠صÙØ© Ù Ø´ عاجبا٠Ù٠شرÙÙ ØÙاتÙØ Ø¯Ùر عÙ٠اÙصÙات اÙØÙÙØ© اÙÙ٠بتØبÙا ÙÙÙ.</p>
<p>اÙراج٠ÙاÙست ز٠اÙÙØ¨Ø³Ø Ù ÙتصÙÙÙ Ø¨Ø¨Ø¹Ø¶Ø Ù Ø§ ÙÙÙعش ÙستغÙÙا ع٠ÙربÙ٠دÙØ ÙÙÙ ÙاØد ÙÙÙÙ Ùاز٠ÙÙÙÙ ÙÙثاÙ٠غطا Ùستر ÙسÙÙ ÙرÙØ٠٠٠تعب اÙدÙÙا.</p>
<p>ÙÙج٠ÙÙسÙ٠بÙÙ..</p>
<h3><strong>اÙسÙ٠اÙØÙÙÙÙ Ù Ø´ Ù٠أ٠عÙاÙØ©</strong></h3>
<p>ربÙا Ø®Ù٠اÙØ¥Ùسا٠بطبÙعة Ù Øتاجة ÙÙسÙÙØ Ù Ø´ بس Ù Ùا٠ÙعÙØ´ ÙÙÙØ ÙÙ٠شرÙÙ ØÙاة ÙØÙÙ ÙÙا اÙراØØ© اÙÙÙسÙØ© ÙاÙسÙÙ٠اÙداخÙÙ. Ùد٠اÙÙ٠ربÙا ÙضØÙ Ù٠اÙÙرآ٠اÙÙرÙÙ Ù٠ا ÙاÙ:</p>
<p>ÙÙÙ ÙÙ٠آÙÙاتÙÙ٠أÙÙÙ Ø®ÙÙÙÙÙ ÙÙÙÙÙ Ù ÙÙÙ٠أÙÙÙÙسÙÙÙ٠٠أÙزÙÙÙاجÙا ÙÙÙتÙسÙÙÙÙÙÙا Ø¥ÙÙÙÙÙÙÙا ÙÙجÙعÙÙ٠بÙÙÙÙÙÙÙÙ Ù ÙÙÙÙدÙÙØ©Ù ÙÙرÙØÙÙ ÙØ©Ù</p>
<p>رÙز ÙÙ ÙÙÙ Ø© &#8220;ÙتسÙÙÙا Ø¥ÙÙÙا&#8221;.<br />
اÙسÙÙ ÙÙا Ù Ø´ ٠جرد ÙجÙد Øد ٠عاÙØ ÙÙÙ٠راØØ© رÙØÙØ© ÙشعÙر باÙأ٠اÙ. ز٠Ù٠ا تÙÙ٠تعباÙØ ÙتÙاÙÙ Ù Ùا٠ÙØضÙÙ ÙÙØ®ÙÙ٠تÙد٠٠ÙÙب٠٠ط٠Ù.</p>
<p>Øت٠سÙدÙا آد٠عÙÙ٠اÙسÙØ§Ù Ø ÙÙÙ Ù٠اÙجÙØ© بÙÙ ÙعÙÙ ÙØ§Ø Øس بÙØدة. تخÙÙ ÙدÙØ Ø§ÙجÙØ©! Ù٠ع Ø°Ù٠استÙØØ´ ÙØ£ÙÙ Ùا٠٠Øتاج شرÙÙ. ربÙا Ø®ÙÙ ÙÙ ØÙاء ٠٠ضÙع٠ÙتؤÙسÙØ ÙتØÙÙ Ù٠اÙسÙ٠اÙØÙÙÙÙ. اÙØ¥Ùسا٠٠ش Ù Ø®ÙÙÙ ÙعÙØ´ ÙÙØدÙØ ÙÙÙ Ù Ø´ أ٠عÙاÙØ© تÙدر تØÙ٠اÙسÙ٠دÙ.</p>
<p>ربÙا Ù٠ا Ùص٠اÙعÙاÙØ© بÙ٠اÙزÙجÙÙØ Ùد٠ÙÙا ٠عادÙØ© Ø¥ÙÙÙØ©: اÙسÙÙØ Ø§ÙÙ ÙØ¯Ø©Ø ÙاÙرØÙ Ø©.</p>
<p>اÙسÙÙ: Ù٠اÙراØØ©Ø Ø§Ùط٠أÙÙÙØ©Ø ÙاÙسÙÙÙØ© اÙÙ٠بتÙج٠٠٠شرÙÙ ÙØ·Ù ÙÙ ÙÙØ®ÙÙ ÙÙب٠ÙادÙ.<br />
اÙÙ Ùدة: اÙØب اÙ٠تباد٠اÙÙ٠بÙÙبر ٠ع اÙÙÙت.<br />
اÙرØÙ Ø©: اÙÙ٠بتØ٠٠اÙعÙاÙØ© ÙتخÙÙ Ù٠طر٠Ùراع٠اÙتاÙÙ Ù Ù٠ا ØصÙ.</p>
<p>ربÙا Ùا٠إ٠اÙعÙاÙØ© د٠٠٠آÙاتÙØ ÙعÙ٠٠عجزة. تخÙÙØ Ø§ÙعÙاÙØ© بÙ٠اتÙÙ٠ربÙا Ø®ÙÙÙ٠٠ختÙÙÙ٠ت٠ا٠ÙØ§Ø Ùجأة ÙتØÙÙÙا ÙشرÙاء ØÙاة ÙØبÙا بعض ÙÙخاÙÙا عÙ٠بعض Ø£Ùتر ٠٠أ٠Øد تاÙÙ. Ùد٠٠ش ٠جرد صدÙØ©Ø ÙÙÙ٠تدبÙر رباÙÙ.</p>
<p>Ù٠اÙجز٠ة ضÙÙØ© Ù Ø´ ÙتÙØ³Ø¹Ø ÙÙ٠اÙعÙاÙØ© ٠ؤذÙØ© Ù Ø´ ÙتتØسÙ. Ù Ø´ Ù ÙØ·Ù٠تÙض٠٠ت٠س٠بØاجة بتأذÙÙØ Ø³Ùاء ÙاÙت جز٠ة ÙÙا عÙاÙØ©. اÙسÙ٠اÙØÙÙÙÙ ÙÙ Ù٠ا تÙاÙÙ Øد ÙØ´Ù٠عÙ٠تعب اÙØ£ÙØ§Ù Ø ÙØ·Ù ÙÙ Ù٠ا تÙÙ٠خاÙÙØ ÙÙÙÙ٠سبب Ø¥Ù٠تشÙر ربÙا عÙÙ ÙجÙد٠ÙÙ ØÙاتÙ.</p>
<p>اÙØÙاة Ø£Ùصر ٠٠إÙ٠تÙض٠٠تعÙ٠بعÙاÙات ٠ؤذÙØ© Ø£Ù Ø°ÙرÙات ÙدÙÙ Ø©. Ù٠اÙعÙاÙØ© اÙÙ٠اÙتÙت Ù Ø´ Ù Ùاسبة ÙÙÙØ Ø³ÙبÙا ترÙØØ Ùادع٠ربÙا ÙرزÙ٠اÙسÙ٠اÙØÙÙÙ٠اÙÙÙ ÙصÙÙ ÙÙ Ùتاب٠اÙÙرÙÙ . ز٠٠ا بتدÙر عÙ٠جز٠ة ٠رÙØØ© عÙÙ Ù ÙاسÙØ Ø¯Ùر عÙ٠عÙاÙØ© ÙÙÙا سÙÙ ÙرÙØÙØ Ùصد٠إ٠اÙسÙ٠اÙØÙÙÙÙ Ù٠٠ع اÙشخص اÙÙ٠ربÙا جعÙÙ ÙÙÙØ Ù Ø´ Ø£Ù Øد ÙØ®Ùاص.</p>